|
#1
|
||||
|
||||
|
أحلام مستغانمي كاتبة تخفي خلف روايتها أبًا لطالما طبع حياتها بشخصيته الفذّة وتاريخه النضاليّ. لن نذهب إلى القول بأنّها أخذت عنه محاور رواياتها اقتباسًا. ولكن ما من شك في أنّ مسيرة حياته التي تحكي تاريخ الجزائر وجدت صدى واسعًا عبر مؤلِّفاتها. كان والدها "محمد الشريف" من هواة الأدب الفرنسي. وقارئًا ذا ميول كلاسيكيّ لأمثال Victor Hugo, Voltaire Jean Jaques, Rousseau,. يستشف ذلك كلّ من يجالسه لأوّل مرّة. كما كانت له القدرة على سرد الكثير من القصص عن مدينته الأصليّة مسقط رأسه "قسنطينة" مع إدماج عنصر الوطنيّة وتاريخ الجزائر في كلّ حوار يخوضه. وذلك بفصاحة فرنسيّة وخطابة نادرة. هذا الأبّ عرف السجون الفرنسيّة, بسبب مشاركته في مظاهرات 8 ماي1945 . وبعد أن أطلق سراحه سنة 1947 كان قد فقد عمله بالبلديّة, ومع ذلك فإنّه يعتبر محظوظاً إذ لم يلق حتفه مع من مات آنذاك (45 ألف شهيد سقطوا خلال تلك المظاهرات) وأصبح ملاحقًا من قبل الشرطة الفرنسيّة, بسبب نشاطه السياسي بعد حلّ حزب الشعب الجزائري. الذي أدّى إلى ولادة ما هو أكثر أهميّة, ويحسب له المستعمر الفرنسي ألف حساب: حزب جبهة التحرير الوطني FLN. وأمّا عن الجدّة فاطمة الزهراء, فقد كانت أكثر ما تخشاه, هو فقدان آخر أبنائها بعد أن ثكلت كل إخوته, أثناء مظاهرات 1945 في مدينة قالمة. هذه المأساة, لم تكن مصيراً لأسرة المستغانمي فقط. بل لكلّ الجزائر من خلال ملايين العائلات التي وجدت نفسها ممزّقة تحت وطأة الدمار الذي خلّفه الإستعمار. بعد أشهر قليلة, يتوّجه محمد الشريف مع أمّه وزوجته وأحزانه إلى تونس كما لو أنّ روحه سحبت منه. فقد ودّع مدينة قسنطينة أرض آبائه وأجداده. كانت تونس فيما مضى مقرًّا لبعض الرِفاق الأمير عبد القادر والمقراني بعد نفيهما. ويجد محمد الشريف نفسه محاطاً بجوٍّ ساخن لا يخلو من النضال, والجهاد في حزبي MTLD و PPA بطريقة تختلف عن نضاله السابق ولكن لا تقلّ أهميّة عن الذين يخوضون المعارك. في هذه الظروف التي كانت تحمل مخاض الثورة, وإرهاصاتها الأولى تولد أحلام في تونس. ولكي تعيش أسرته, يضطر الوالد للعمل كمدرّس للّغة الفرنسيّة. لأنّه لا يملك تأهيلاً غير تلك اللّغة, لذلك, سوف يبذل الأب كلّ ما بوسعه بعد ذلك, لتتعلَّم ابنته اللغة العربيّة التي مُنع هو من تعلمها. وبالإضافة إلى عمله, ناضل محمد الشريف في حزب الدستور التونسي (منزل تميم) محافظًا بذلك على نشاطه النضالي المغاربيّ ضد الإستعمار. وعندما اندلعت الثورة الجزائريّة في أوّل نوفمبر 1954 شارك أبناء إخوته عزّ الدين وبديعة اللذان كانا يقيمان تحت كنفه منذ قتل والدهما, شاركا في مظاهرات طلاّبيّة تضامنًا مع المجاهدين قبل أن يلتحقا فيما بعد سنة 1955 بالأوراس الجزائريّة. وتصبح بديعة الحاصلة لتوّها على الباكالوريا, من أولى الفتيات الجزائريات اللاتي استبدلن بالجامعة الرشّاش, وانخرطن في الكفاح المسلَّح. ما زلت لحدّ الآن, صور بديعة تظهر في الأفلام الوثائقية عن الثورة الجزائرية. حيث تبدو بالزي العسكري رفقة المجاهدين. وما زالت بعض آثار تلك الأحداث في ذاكرة أحلام الطفوليّة. حيث كان منزل أبيها مركزاً يلتقي فيه المجاهدون الذين سيلتحقون بالجبال, أو العائدين للمعالجة في تونس من الإصابات. بعد الإستقلال, عاد جميع أفراد الأسرة إلى الوطن. واستقرّ الأب في العاصمة حيث كان يشغل منصب مستشار تقنيّ لدى رئاسة الجمهوريّة, ثم مديراً في وزارة الفلاحة, وأوّل مسؤول عن إدارة وتوزيع الأملاك الشاغرة, والمزارع والأراضي الفلاحيّة التي تركها المعمّرون الفرنسيون بعد مغادرتهم الجزائر. إضافة إلى نشاطه الدائم في اتحاد العمال الجزائريّين, الذي كان أحد ممثليه أثناء حرب التحرير. غير أن حماسه لبناء الجزائر المستقلّة لتوّها, جعله يتطوّع في كل مشروع يساعد في الإسراع في إعمارها. وهكذا إضافة إلى المهمّات التي كان يقوم بها داخليًّا لتفقّد أوضاع الفلاّحين, تطوَّع لإعداد برنامج إذاعي (باللّغة الفرنسيّة) لشرح خطة التسيير الذاتي الفلاحي. ثمّ ساهم في حملة محو الأميّة التي دعا إليها الرئيس أحمد بن بلّة بإشرافه على إعداد كتب لهذه الغاية. وهكذا نشأت ابنته الكبرى في محيط عائلي يلعب الأب فيه دورًا أساسيًّا. وكانت مقرّبة كثيرًا من أبيها وخالها عزّ الدين الضابط في جيش التحرير الذي كان كأخيها الأكبر. عبر هاتين الشخصيتين, عاشت كلّ المؤثّرات التي تطرأ على الساحة السياسيّة. و التي كشفت لها عن بعد أعمق, للجرح الجزائري (التصحيح الثوري للعقيد هواري بومدين, ومحاولة الانقلاب للعقيد الطاهر زبيري), عاشت الأزمة الجزائرية يومًّا بيوم من خلال مشاركة أبيها في حياته العمليّة, وحواراته الدائمة معها. لم تكن أحلام غريبة عن ماضي الجزائر, ولا عن الحاضر الذي يعيشه الوطن. مما جعل كلّ مؤلفاتها تحمل شيئًا عن والدها, وإن لم يأتِ ذكره صراحة. فقد ترك بصماته عليها إلى الأبد. بدءًا من اختياره العربيّة لغة لها. لتثأر له بها. فحال إستقلال الجزائر ستكون أحلام مع أوّل فوج للبنات يتابع تعليمه في مدرسة الثعالبيّة, أولى مدرسة معرّبة للبنات في العاصمة. وتنتقل منها إلى ثانوية عائشة أم المؤمنين. لتتخرّج سنة 1971 من كليّة الآداب في الجزائر ضمن أوّل دفعة معرّبة تتخرّج بعد الإستقلال من جامعات الجزائر. لكن قبل ذلك, سنة 1967, وإثر إنقلاب بومدين واعتقال الرئيس أحمد بن بلّة. يقع الأب مريضًا نتيجة للخلافات "القبليّة" والانقلابات السياسيّة التي أصبح فيها رفاق الأمس ألدّ الأعداء. هذه الأزمة النفسيّة, أو الانهيار العصبيّ الذي أصابه, جعله يفقد صوابه في بعض الأحيان. خاصة بعد تعرّضه لمحاولة اغتيال, مما أدّى إلى الإقامة من حين لآخر في مصحّ عقليّ تابع للجيش الوطني الشعبيّ. كانت أحلام آنذاك في سن المراهقة, طالبة في ثانوية عائشة بالعاصمة. وبما أنّها كانت أكبر إخواتها الأربعة, كان عليها هي أن تزور والدها في المستشفى المذكور, والواقع في حيّ باب الواد, ثلاث مرّات على الأقلّ كلّ أسبوع. كان مرض أبيها مرض الجزائر. هكذا كانت تراه وتعيشه. قبل أن تبلغ أحلام الثامنة عشرة عاماً. وأثناء إعدادها لشهادة الباكلوريا, كان عليها ان تعمل لتساهم في إعالة إخوتها وعائلة تركها الوالد دون مورد. ولذا خلال ثلاث سنوات كانت أحلام تعدّ وتقدّم برنامجًا يوميًا في الإذاعة الجزائريّة يبثّ في ساعة متأخرّة من المساء تحت عنوان "همسات". وقد لاقت تلك "الوشوشات" الشعريّة نجاحًا كبيرًا تجاوز الحدود الجزائرية الى دول المغرب العربي. وساهمت في ميلاد إسم أحلام مستغانمي الشعريّ, الذي وجد له سندًا في صوتها الأذاعيّ المميّز وفي مقالات وقصائد كانت تنشرها أحلام في الصحافة الجزائرية. وديوان أوّل أصدرته سنة 1971 في الجزائر تحت عنوان "على مرفأ الأيام". في هذا الوقت لم يكن أبوها حاضراً ليشهد ما حقّفته ابنته. بل كان يتواجد في المستشفى لفترات طويلة, بعد أن ساءت حالته. هذا الوضع سبّب لأحلام معاناة كبيرة. فقد كانت كلّ نجاحاتها من أجل إسعاده هو, برغم علمها أنّه لن يتمكن يومًا من قراءتها لعدم إتقانه القراءة بالعربية. وكانت فاجعة الأب الثانية, عندما انفصلت عنه أحلام وذهبت لتقيم في باريس حيث تزوّجت من صحفي لبناني ممن يكنّون ودًّا كبيرًا للجزائريين. وابتعدت عن الحياة الثقافية لبضع سنوات كي تكرِّس حياتها لأسرتها. قبل أن تعود في بداية الثمانينات لتتعاطى مع الأدب العربيّ من جديد. أوّلاً بتحضير شهادة دكتوراه في جامعة السوربون. ثمّ مشاركتها في الكتابة في مجلّة "الحوار" التي كان يصدرها زوجها من باريس, ومجلة "التضامن" التي كانت تصدر من لندن. أثناء ذلك وجد الأب نفسه في مواجهة المرض والشيخوخة والوحدة. وراح يتواصل معها بالكتابة إليها في كلّ مناسبة وطنية عن ذاكرته النضاليّة وذلك الزمن الجميل الذي عاشه مع الرفاق في قسنطينة. ثمّ ذات يوم توّقفت تلك الرسائل الطويلة المكتوبة دائمًا بخط أنيق وتعابير منتقاة. كان ذلك الأب الذي لا يفوّت مناسبة, مشغولاً بانتقاء تاريخ موته, كما لو كان يختار عنوانًا لقصائده. في ليلة أوّل نوفمبر 1992, التاريخ المصادف لاندلاع الثورة الجزائريّة, كان محمد الشريف يوارى التراب في مقبرة العلياء, غير بعيد عن قبور رفاقه. كما لو كان يعود إلى الجزائر مع شهدائها. بتوقيت الرصاصة الأولى. فقد كان أحد ضحاياها وشهدائها الأحياء. وكان جثمانه يغادر مصادفة المستشفى العسكري على وقع النشيد الوطنيّ الذي كان يعزف لرفع العلم بمناسبة أوّل نوفمبر. ومصادفة أيضًا, كانت السيارات العسكريّة تنقل نحو المستشفى الجثث المشوّهة لعدّة جنود قد تمّ التنكيل بهم على يد من لم يكن بعد معترفًا بوجودهم كجبهة إسلاميّة مسلّحة. لقد أغمض عينيه قبل ذلك بقليل, متوجّسًا الفاجعة. ذلك الرجل الذي أدهش مرة إحدى الصحافيّات عندما سألته عن سيرته النضاليّة, فأجابها مستخفًّا بعمر قضاه بين المعتقلات والمصحّات والمنافي, قائلاً: "إن كنت جئت إلى العالم فقط لأنجب أحلام. فهذا يكفيني فخرًا. إنّها أهمّ إنجازاتي. أريد أن يقال إنني "أبو أحلام" أن أنسب إليها.. كما تنسب هي لي". كان يدري وهو الشاعر, أنّ الكلمة هي الأبقى. وهي الأرفع. ولذا حمَّل ابنته إرثًا نضاليًا لا نجاة منه. بحكم الظروف التاريخيّة لميلاد قلمها, الذي جاء منغمسًا في القضايا الوطنيّة والقوميّة التي نذرت لها أحلام أدبها. وفاءًا لقارىء لن يقرأها يومًا.. ولم تكتب أحلام سواه. عساها بأدبها تردّ عنه بعض ما ألحق الوطن من أذى بأحلامه. مراد مستغانمي شقيق الكاتبة الجزائر حزيران 2001 إصدارات: « ذاكرة الجسد » ـ صادرة عن دار الآداب ببيروت سنة 1993 ـ وصلت اليوم إلى طبعتها الـ 18 ـ جائزة نور،تمنح لأحسن إبداع نسائي باللغة العربية، منحت لها سنة 1996 من مؤسسة نور بالقاهرة. ـ جائزة نجيب محفوظ، للرواية، جائزة في مستوى المسابقة، منحت لها من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 1998،مما جعلها تترجم إلى لغات عالمية عديدة. حازت الرواية أيضا على جائزة "جورج تراباي" الذي يكرّم كل سنة أفضل عمل أدبي كبير منشور في لبنان . ترجمت الرواية إلى لغات عديدة منها الإنجليزية بواسطة بارعة الأحمر ، وإلى اللغة الإيطالية بواسطة فرانسيسكو ليجيو، و إلى الفرنسيةـ منشورات ألبين ميشيل ـ بواسطة محمد مقدم. ـ في طريق الصدور باللّغات ( الألمانية، الأسبانية، الصينية، الكردية) ـ أدخلت الرواية في المقرر التعليمي للعديد من الجامعات الدولية، وفي جامعات عربية أيضا ( السربون بباريس،جامعة ليون، جامعة ماريلاند بواشنطن،الجامعة الأمريكية ببيروت و القاهرة،جامعة عمان بالأردن،الجامعة الجزائرية، جامعة سانت ـ جوزيف بيروت....) و أيضا في برنامج الثانوية العامة بلبنان. ـ كانت الرواية موضوعا لأطروحات الدكتوراه، ولبحوث جامعية كثيرة. ـ اعتبرها النقاد كأحسن عمل روائي صادر في العقد الأخير. «فوضى الحواس» L'anarchie des sens ـ صادرة عن دار الآداب ببيروت سنة 1997، وصلت اليوم الى طبعتها الـ15. ـ نتيجة لعقد مبرم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة،فالرواية في طريقها الى الترجمه الى العديد من اللغات الأجنبية. «عابر سرير» Passager d'un lit سنة النشر: 2003 الناشر: منشورات أحلام مستغانمي «على مرفأ الأيام » Au havre des jours صادر عن المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر سنة 1973 « أكاذيب سمكة » Mensonges d'un poisson صادر عن المؤسسة الوطنية للنشر سنة 1993 «الكتابة في لحظة عري » Ecriture dans un moment de nudité صادر عن دار الآداب ببيروت سنة 1976 « الجزائر، امرأة ونصوص » Algérie Femme et écritures صادر عن منشورات " أرماتان" بباريس سنة 1985 |
|
#2
|
||||
|
||||
|
عابر سرير اهداء الى أبي... دوما. والى شرفاء هذه الأمة ورجالها الرائعين, الذين يعبرون بأقدارهم دون انحناء, متشبثين بأحلام الخاسرين. واليك في فتنة عبورك الشامخ, عبورك الجامح,يوم تعثر بك قدري... كي تقيم. أحلام "عابرة سبيل هي الحقيقة.. ولا شيء يستطيع أن يعترض سبيلها". ايميل زولا الفصل الأول كنا مساء اللهفة الأولى, عاشقين في ضيافة المطر, رتبت لهما المصادفة موعدا خارج المدن العربية للخوف. نسينا لليلة أن نكون على حذر, ظنا منا أن باريس تمتهن حراسة العشاق. إن حبا عاش تحت رحمة القتلة, لا بد أن يحتمي خلف أول متراس متاح للبهجة. أكنا إذن نتمرن رقصا على منصة السعادة, أثناء اعتقادنا أن الفرح فعل مقاومة؟ أم أن بعض الحزن من لوازم العشاق؟ في مساء الولع العائد مخضبا بالشجن. يصبح همك كيف تفكك لغم الحب بعد عامين من الغياب, وتعطل فتيله الموقوت, دون أن تتشظى بوحا. بعنف معانقة بعد فراق, تود لو قلت "أحبك" كما لو تقول "ما زلت مريضا بك". تريد أم تقول كلمات متعذرة اللفظ , كعواطف تترفع عن التعبير, كمرض عصي على التشخيص. تود لو استطعت البكاء. لا لأنك في بيته, لا لأنكما معا, لا لأنها أخيرا جاءت, لا لأنك تعيس ولا لكونك سعيدا, بل لجمالية البكاء أمام شيء فاتن لن يتكرر كمصادفة. التاسعة والربع ,وأعقاب سجائر. وقبل سيجارة من ضحكتها الماطرة التي رطبت كبريت حزنك. كنت ستسألها , كيف ثغرها في غيابك بلغ سن الرشد؟ وبعيد قبلة لم تقع, كنت ستستفسر: ماذا فعلت بشفتيها في غيبتك؟ من رأت عيناها؟ لمن تعرى صوتها؟ لمن قالت كلاما كان لك؟ هذه المرأة التي على ايقاع الدفوف القسنطينية, تطارحك الرقص كما لو كانت تطارحك البكاء. ماالذي يدوزن وقع أقدامها, لتحدث هذا الاضطراب الكوني من حولك؟ كل ذاك المطر. وأنت عند قدميها ترتل صلوات الاستسقاء. تشعر بانتماءك الى كل أنواع الغيوم. الى كل أحزاب البكاء, الى كل الدموع المنهطلة بسبب النساء. هي هنا. وماذا تفعل بكل هذا الشجن؟ أنت الرجل الذي لا يبكي بل يدمع, لا يرقص بل يطرب, لا يغني بل يشجى. أمام كل هذا الزخم العاطفي, لا ينتابك غير هاجس التفاصيل, متربصا دوما برواية. تبحث عن الأمان في الكتابة؟ يا للغباء! ألأنك هنا, لا وطن لك ولا بيت, قررت أن تصبح من نزلاء الرواية, ذاهبا الى الكتابة, كما يذهب آخرون الى الرقص, كما يذهب الكثيرون الى النساء, كما يذهب الأغبياء الى حتفهم؟ أتنازل الموت في كتاب؟ أم تحتمي من الموت بقلم؟ كنا في غرفة الجلوس متقابلين, على مرمى خدعة من المخدع. عاجزين على انتزاع فتيل قنبلة الغيرة تحت سرير صار لغيرنا. لموعدنا هذا , كانت تلزمنا مناطق منزوعة الذكريات, مجردة من مؤامرة الأشياء علينا, بعيدة عن كمين الذاكرة. فلماذا جئت بها إلى هذا البيت بالذات, إذا كنت تخاف أن يتسرب الحزن إلى قدميها؟ ذلك أن بي شغفا إلى قدميها. وهذه حالة جديدة في الحب. فقبلها لم يحدث أن تعلقت بأقدام النساء. هي ما تعودت أن تخلع الكعب العالي لضحكتها, لحظة تمشي على حزن رجل. لكنها انحنت ببطء أنثوي, كما تنحني زنبقة برأسها, وبدون أن تخلع صمتها, خلعت ما علق بنعليها من دمي, وراحت تواصل الرقص حافية مني. أكانت تعي وقع انحنائها الجميل على خساراتي, وغواية قدميها عندما تخلعان أو تنتعلان قلب رجل؟ شيء ما فيها, كان يذكرني بمشهد "ريتا هاورث" في ذلك الزمن الجميل للسينما, وهي تخلع قفازيها السوداوين الطويلين من الساتان, إصبعا إصبعا, بذلك البطء المتعمد, فتدوخ كل رجال العالم بدون أن تكون قد خلعت شيئا. هل من هنا جاء شغف المبدعين بتفاصيل النساء؟ ولذا مات بوشكين في نزال غبي دفاعا عن شرف قدمي زوجة لم تكن تقرأه. في حضرتها كان الحزن يبدو جميلا. وكنت لجماليته, أريد أن أحتفظ بتفاصيله متقدة في ذاكرتي, أمعن النظر إلى تلك الأنثى التي ترقص على أنغام الرغبة, كما على خوان المنتصرين, حافية من الرحمة بينما أتوسد خسارات عمري عند قدميها. هي ذي , كما الحياة جاءت, مباغتة كل التوقعات, لكأنها تذهب الى كل حب حافية مبللة القدمين دوما, لكأنها خارجة لتوها من بركة الخطايا أو ذاهبة صوبها. اشتقتها! كم اشتقتها, هذه المرأة التي لم أعد أعرف قرابتي بها, فأصبحت أنتسب الى قدميها. هي ذي . وأنا خائف, إن أطلت النظر إلى العرق اللامع على عري ظهرها , أن يصعقني تيار الأنوثة. هي أشهى, هكذا. كامرأة تمضي مولية ظهرها, تمنحك فرصة تصورها, تتركك مشتعلا بمسافة مستحيلها. أنا الرجل الذي يحب مطاردة شذى عابرة سبيل, تمر دون أن تلتفت. تميتني امرأة تحتضنها أوهامي من الخلف. ولهذا اقتنيت لها هذا الفستان الأسود من الموسلين, بسبب شهقة الفتحة التي تعري ظهره, وتسمرني أمام مساحة يطل منها ضوء عتمتها. أو ربما اقتنيته بسبب تلك الاهانة المستترة التي اشتممتها من جواب بائعة, لم تكن تصدق تماما أن بامكان عربي ذي مظهر لا تفوح منه رائحة النفط, أن ينتمي الى فحش عالم الاقتناء. كنت أتجول مشيا قادما من الأوبرا, عندما قادتني قدماي الى "فوبور سانت أونوريه" . ما احتطت من شارع تقف على جانبيه سيارات فخمة في انتظار نساء محملات بأكياس فائقة التميز, ولا توجست من محلات لا تضع في واجهاتها سوى ثوب واحد أو ثوبين. لم أكن أعرف ذلك الحي , أصلا. عرفت اسم الحي في مابعد, عندما أمدتني البائعة ببطاقة عليها العربون الذي دفعته لأحجز به ذلك الثوب. بتلك الأنفة المشوبة بالجنون, بمنطق" النيف" الجزائري تشتري فستان سهرة يعادل ثمنه معاشك في الجزائر لعدة شهور, أنت الذي تضن على نفسك بالأقل. أفعلت ذلك رغبة منك في تبذير مال تلك الجائزة التي حصلت عليها, كما لتنجو من لعنة؟ أم لتثبت للحب أنك الأكثر سخاء منه؟ أن تشتري فستان سهرة لامرأة لم تعد تتوقع عودتها, ولا تعرف في غيابك ماذا فعل الزمن بقياساتها, أهي رشوة منك للقدر؟ أم معابثة منك للذاكرة؟ فأنت تدري أن هذا الفستان الذي بنيت عليه قصة من الموسلين لم يوجد يوما, ولكن الأسود يصلح ذريعة لكل شيء. ولذا هو لون أساسي في كل خدعة. أذكر يوم صادفتها في ذلك المقهى, منذ أكثر من سنتين, لم أجد سوى ذريعة من الموسلين لمبادرتها. سائلا ان كانت هي التي رأيتها مرة في حفل زفاف, مرتدية ثوبا طويلا من الموسلين الأسود. ارتبكت. أظنها كانت ستقول"لا" ولكنها قالت "ربما" . أحرجها أن تقول " نعم ". في الواقع, لم نكن التقينا بعد. لكنني كنت أحب أن أختلق, مع امرأة , ذكريات ماض لم يكن. أحب كل ذاكرة لا منطق لها. بدأنا منذ تلك اللحظة نفصل قصة على قياس ثوب لم يوجد يوما في خزانتها. عندما استوقفني ذلك الفستان قبل شهرين في واجهة محل, شعرت أنني أعرفه. أحببت انسيابه العاطفي. لكأنه كان يطالب بجسدها أن يرتديه, أو كأنه حدث لها أن ارتدته في سهرة ما , ثم علقته على " الجسد المشجب" لامرأة أخرى , ريثما تعود. عندما دخلت المحل , كنت مرتبكا كرجل ضائع بين ملابس النساء. فأجبت بأجوبة غبية عن الأسئلة البديهية لتلك البائعة المفرطة في الأناقة قدر فرطها في التشكك بنيتي. Dans quelle taille voulez-vous cette robe Monsieur? كيف لي أن أعرف قياس امرأة ما سبرت جسدها يوما الا بشفاه اللهفة؟ امرأة أقيس اهتزازاتها بمعيار ريختر الشبقي. أعرف الطبقات السفلية لشهوتها. أعرف في أي عصر تراكمت حفريات رغباتها, وفي أي زمن جيولوجي استدار حزام زلازلها, وعلى أي عمق تكمن مياه أنوثتها الجوفية. أعرف كل هذا... ولم أعد , منذ سنتين ,أعرف قياس ثوبها! لم تفاجأ البائعة كثيرا بأميتي, أو ألا يكون ثمن ذلك الثوب في حوزتي. فلم يكن في هيئتي ما يوحي بمعرفتي بشؤون النساء, ولا بقدرتي على دفع ذلك المبلغ. غير أنها فوجئت بثقافتي عندما تعمدت أن أقول لها بأنني غير معني باسم مصمم هذا الفستان, بقدر ما يعنيني تواضعه أمام اللون الأسود, حتى لكأنه ترك لهذا اللون أن يوقع الثوب نيابة عنه, في مكمن الضوء, وأنني أشتري ضوء ظهر عار بثمن فستان! قالت كمن يستدرك: - أنت رجل ذواقة. ولأنني لك أصدق مديحها, لاقتناعي أن الذوق لمثلها يرقى وينحط بفراغ وامتلاء محفظة نقود, قلت: - هي ليست قضية ذوق, بل قضية ضوء. المهم ليس الشيء بل إسقاطات الضوء عليه. سالفادور دالي أحب Gala وقرر خطفها من زوجها الشاعر بول ايلوار لحظة رؤيته ظهرها العاري في البحر صيف 1949. سألتني مندهشة لحديث لم يعودها عليه زبائن , شراء مثل هذا الثوب ليس حدثا في ميزانيتهم. - هل أنت رسام؟ كدت أجيب " بل أنا عاشق" . لكنني قلت: - لا ... أنا مصور. وكان يمكن أن أضيف أنني مصور " كبير" , مادمت موجودا في باريس لحصولي على جائزة أحسن صورة صحافية عامئذ. فلم يكن في تلك الصورة التي نلتها مناصفة مع الموت, ما يغري فضول امرأة مثلها. ولذا هي لن تفهم أن يكون هذا الثوب الأسود هو أحد الاستثمارات العاطفية التي أحببت أن أنفق عليها ما حصلت عليه من تلك المكافأة. من قال إن الأقدار ستأتي بها حتى باريس, وإنني سأراه يرتديها؟ هاهي ترتديه . تتفتح داخله كوردة نارية. هي أشهى هكذا, وهي تراقص في حضوري رجلا غيري, هو الحاضر بيننا بكل تفاصيل الغياب. لو رأى بورخيس تلك المرأة ترقص لنا معا, أنا وهو, لوجد " للزاندالي" قرابة بالرقص الأرجنتيني, كما التانغو, انه " فكر حزين يرقص" على إيقاع الغيرة لفض خلافات العشاق. في لحظة ما , لم تعد امرأة . كانت الهة إغريقية ترقص حافية لحظة انخطاف. بعد ذلك سأكتشف أنها كانت الهة تحب رائحة الشواء البشري, ترقص حول محرقة عشاق تعاف قرابينهم ولا تشتهي غيرهم قربانا. لكأنها كانت قسنطينة, كلما تحرك شيء فيها , حدث اضطراب جيولوجي واهتزت الجسور من حولها, ولا يمكنها أن ترقص إلا على جثث رجالها. هذه الفكرة لم تفارقني عندما حاولت فيما بعد فهم نزعاتها المجوسية. ماالذي صنع من تلك المرأة روائية تواصل , في كتاب, مراقصة قتلاها؟ أتلك النار التي خسارة بعد أخرى, أشعلت قلمها بحرائق جسد عصي على الاطفاء؟ أم هي رغبتها في تحريض الريح, باضرام النار في مستودعات التاريخ التي سطا عليها رجال العصابات؟ في الواقع كنت أحب شجاعتها, عندما تنازل الطغاة وقطاع طرق التاريخ, ومجازفتها بتهريب ذلك الكم من البارود في كتاب. ولا أفهم جبنها في الحياة, عندما يتعلق الأمر بمواجهة زوج. تماما, كما لا أجد تفسيرا لذكائها في رواية, وغبائها خارج الأدب, الى حد عدم قدرتها, وهي التي تبدو خبيرة في النفس البشرية, على التمييز بين من هو مستعد للموت من أجلها, ومن هو مستعد أن يبذل حياته من أجل قتلها. انه عماء المبدعين في سذاجة طفولتهم الأبدية. ربما كان عذرها في كونها طفلة تلهو في كتاب. هي لا تأخذ نفسها مأخذ الأدب, ولا تأخذ الكتابة مأخذ الجد. وحدها النار تعنيها. ولذا, قلت لها يوما: " لن أنتزع منك أعواد الثقاب, واصلي اللهو بالنار من أجل الحرائق القادمة". ذلك أن الرواية لم تكن بالنسبة لها, سوى آخر طريق لتمرير الأفكار الخطرة تحت مسميات بريئة. هي التي يحلو لها التحايل على الجمارك العربية, وعلى نقاط التفتيش, ماذا تراها تخبئ في حقائبها الثقيلة, وكتبها السميكة؟ أنيقة حقائبها. سوداء دائما. كثيرة الجيوب السرية, كرواية نسائية , مرتبة بنية تضليلية, كحقيبة امرأة تريد إقناعك أنها لا تخفي شيئا. ولكنها سريعة الانفتاح كحقائب البؤساء من المغتربين. أكل كاتب غريب يشي به قفل, غير محكم الإغلاق, لحقيبة أتعبها الترحال, لا يدري صاحبها متى, ولا في أي محطة من العمر, يتدفق محتواها أمام الغرباء, فيتدافعون لمساعدته على لملمة أشيائه المبعثرة أمامهم لمزيد من التلصص عليه؟ وغالبا ما يفاجأون بحاجاتهم مخبأة مع أشيائه. الروائي سارق بامتياز. سارق محترم. لا يمكن لأحد أن يثبت أنه سطا على تفاصيل حياته أو على أحلامه السرية. من هنا فضولنا أمام كتاباته, كفضولنا أمام حقائب الغرباء المفتوحة على السجاد الكهربائي للأمتعة. أذكر, يوم انفتحت حقيبة تلك المرأة أمامي لأول مرة , كنت يومها على سرير المرض في المستشفى, عندما خطر على بال عبد الحق, زميلي في الجريدة, أن يهديني ذلك الكتاب.. كتابها. كنت أتماثل للشفاء من رصاصتين تلقيتهما في ذراعي اليسرى, وأنا أحاول التقاط صور للمتظاهرين أثناء أحداث أكتوبر 1988 . كانت البلاد تشهد أول تظاهرة شعبية لها منذ الاستقلال, والغضب ينزل الى الشوارع لأول مرة, ومعه الرصاص والدمار والفوضى. لم أعرف يومها , أتلقيت تينك الرصاصتين من أعلى أحد المباني الرسمية , عن قصد أم عن خطأ؟ أكان العسكر يظنون أنني أمسك سلاحا أصوبه نحوهم, أم كانوا يدرون أنني لا أمسك بغير آلة تصويري, عندما أطلقوا رصاصهم نحوي قصد اغتيال شاهد إثبات. تماما, كما سوف لن أدري يوما: أعن قصد, أم عن مصادفة جاءني عبد الحق بذلك الكتاب. أكان ذلك الكتاب هدية القدر؟ أم رصاصته الأخرى؟ أكان حدثا أم حادثا آخر في حياتي؟ ربما كان الاثنان معا. ليس الحب, ولا الاعجاب, بل الذعر هو أول احساس فاجأني أمام ذلك الكتاب ." ليس الجمال سوى بداية ذعر يكاد لا يحتمل" . وكنت مذعورا أمام تلك الرؤى الفجائية الصاعقة, أمام ذلك الارتطام المدوي بالآخر. أي شيء جميل هو في نهايته كارثة. وكيف لا أخشى حالة من الجمال.. كان يزمني عمر من البشاعة لبلوغها. كنت أدخل مدار الحب والذعر معا, وأنا أفتح ذلك الكتاب. منذ الصفحة الأولى تبعثرت أشياء تلك المرأة على فراش مرضي. كانت امرأة ترتب خزانتها في حضرتك. تفرغ حقيبتها وتعلق ثيابها أمامك, قطعة قطعة, وهي تستمع الى موسيقى تيودوراكيس, أو تدندن أغنية لديميس روسوس. كيف تقاوم شهوة التلصص على امرأة, تبدو كأنها لا تشعر بوجودك في غرفتها , مشغولة عنك بترتيب ذاكرتها؟ وعندما تبدأ في السعال كي تنبهها الى وجودك, تدعوك الى الجلوس على ناصية سريرها, وتروح تقص عليك أسرارا ليست سوى أسرارك, واذ بك تكتشف أنها كانت تخرج من حقيبتها ثيابك, منامتك, وأدوات حلاقتك, وعطرك , وجواربك, وحتى الرصاصتين اللتين اخترقا ذراعك. عندها تغلق الكتاب خوفا من قدر بطل أصبحت تشبهه حتى في عاهته. ويصبح همك, كيف التعرف على امرأة عشت معها أكبر مغامرة داخلية. كالبراكين البحرية, كل شيء حدث داخلك. وأنت تريد أن تراها فقط, لتسألها " كيف تسنى لها أن تملأ حقيبتها بك؟" ثمة كتب عليك أن تقرأها قراءة حذرة. أفي ذلك الكتاب اكتشفت مسدسها مخبأ بين ثنايا ثيابها النسائية, وجملها المواربة القصيرة؟ لكأنها كانت تكتب لتردي أحدا قتيلا, شخصا وحدها تعرفه. ولكن يحدث أن تطلق النار عليه فتصيبك. كانت تملك تلك القدرة النادرة على تدبير جريمة حبر بين جملتين, وعلى دفن قارئ أوجده فضوله في جنازة غيره. كل ذلك يحدث أثناء انشغالها بتنظيف سلاح الكلمات! كنت أراها تكفن جثة حبيب في رواية, بذلك القدر من العناية, كما تلفلف الأم رضيعا بعد حمامه الأول. عندما تقول امرأة عاقر: " في حياة الكاتب تتناسل الكتب", هي حتما تعني "تتناسل الجثث" وأنا كنت أريدها أن تحبل مني , أن أقيم في أحشائها, خشية أن أنتهي جثة في كتاب. كنت مع كل نشوة أتصبب لغة صارخا بها: " احبلي .. إنها هنيهة الإخصاب" وكانت شفتاي تلعقان لثما دمع العقم المنحدر على خديها مدرارا كأنه اعتذار. أحاسيس لم أعرفها مع زوجتي التي كنت لسنوات أفرض عليها تناول حبوب منع الحمل, مهووسا بخوفي أن أغتال فتتكرر في طفلي مأساتي. فكرة أن أترك ابني يتيما كانت تعذبني, حتى انني في الفترة التي تلت اغتيال عبد الحق, كنت أستيقظ مذعورا كما على صوت بكاء رضيع. مع حياة ,اكتشفت أن الأبوة فعل حب, وهي التي لم أحلم بالإنجاب من سواها. كان لي معها دوما "حمل كاذب". لكن, إن كنا لا ننجب من "حمل كاذب" , فإننا نجهضه. بل كل إجهاض ليس سوى نتيجة حمل تم خارج رحم المنطق, وما خلقت الروايات إلا لحاجتنا الى مقبرة تنام فيها أحلامنا الموءودة. إن كنت أجلس اليوم لأكتب , فلأنها ماتت. بعدما قتلتها, عدت لأمثل تفاصيل الجريمة في كتاب. كمصور يتردد في اختيار الزاوية التي يلتقط منها صورته, لا أدري من أي مدخل أكتب هذه القصة التي التقطت صورها من قرب, من الزوايا العريضة للحقيقة. وبمنطق الصورة نفسها التي تلتقطها آلة التصوير معكوسة, ولا تعود الى وجهها الحقيقي الا بعدما يتم تظهيرها في مختبر, يلزمني تقبل فكرة أن كل شيء يولد مقلوبا, وان الناس الذين نراهم معكوسين, هم كذلك, لأننا التقينا بهم, قبل أن تتكفل الحياة بقلب حقيقتهم في مختبرها لتظهير البشر. إنهم أفلام محروقة أتلفتها فاجعة الضوء, ولا جدوى من الاحتفاظ بهم. لقد ولدوا موتى. ليس ثمة موتى غير أولئك الذين نواريهم في مقبرة الذاكرة. اذن يمكننا بالنسيان, أن نشيع موتا من شئنا من الأحياء, فنستيقظ ذات صباح ونقرر أنهم ما عادوا هنا. بامكاننا أن نلفق لهم ميتة في كتاب, أن نخترع لهم وفاة داهمة بسكتة قلمية مباغتة كحادث سير, مفجعة كحادثة غرق, ولا يعنينا ذكراهم لنبكيها, كما نبكي الموتى. نحتاج أن نتخلص من أشيائهم, من هداياهم, من رسائلهم, من تشابك ذاكرتنا بهم. نحتاج على وجه السرعة أن تلبس حدادهم بعض الوقت, ثم ننسى. ! |
|
#3
|
||||
|
||||
|
لتشفى من حالة عشقية, يلزمك رفاة حب, لاتمثالا لحبيب تواصل تلميعه بعد الفراق, مصرا على ذياك البريق الذي انخطفت به يوما. يلزمك قبر ورخام وشجاعة لدفن من كان أقرب الناس اليك.
أنت من يتأمل جثة حب في طور التعفن, لا تحتفظ بحب ميت في براد الذاكرة, أكتب , لمثل هذا خلقت الروايات. أذكر تلك الأجوبة الطريفة لكتاب سئلوا لماذا يكتبون. أجاب أحدهم " ليجاور الأحياء الأموات" , وأجاب آخر " كي أسخر من المقابر" , ورد ثالث " كي أضرب موعدا" . أين يمكنك, الا في كتاب, أن تضرب موعدا لامرأة سبق أن ابتكرت خديعة موتها, مصرا على إقحام جثتها في موكب الأحياء, برغم بؤس المعاشرة. أليس في هذه المفارقة سخرية من المقابر التي تضم تحت رخامها , وتترك الأموات يمشون ويجيئون في شوارع حياتنا. وكنت قرأت أن (الغوليين) سكان فرنسا الأوائل, كانوا يرمون الى النار الرسائل التي يريدون إرسالها الى موتاهم. وبمكاتيب محملة بسلاماتهم وأشواقهم وفجيعتهم. وحدها النار, تصلح ساعي بريد. وحدها بامكانها انقاذ الحريق. أكل ذلك الرماد, الذي كان نارا, من أجل صنع كتاب جميل؟ حرائقك التي تنطفئ كلما تقدمت في الكتابة, لا بد أن تجمع رمادها صفحة صفحة, وترسله الى موتاك بالبريد المسجل, فلا توجد وسيلة أكثر ضمانا من كتاب. تعلم اذن أن تقضي سنوات في انجاز حفنة من رماد الكلمات, لمتعة رمي كتاب الى البحر, أن تبعثر في البحر رماد من أحببت, غير مهتم بكون البحر لا يؤتمن على رسالة, تماما كما القارئ لا يؤتمن على كتاب. فكتابة رواية تشبه وضع رسالة في زجاجة والقائها في البحر. وقد تقع في أيدي أصدقاء أو أعداء غير متوقعين. يقول غراهام غرين, ناسيا أن يضيف أنه في أغلب الظن ستصطدم بجثث كانت لعشاق لنا يقبعون في قعر محيط النسيان. بعد أن غرقوا مربوطين الى صخرة جبروتهم وأنانيتهم. ما كان لنا الا أن نشغل أيدينا بكتابة رواية, حتى لا تمتد الة حتف انقاذهم. بامكانهم بعد ذلك, أن يباهوا بأنهم المعنيون برفاة حب محنط في كتاب. ام حبا نكتب عنه, هو حب لم يعد موجودا, وكتابا نوزع آلاف النسخ منه, ليس سوى رماد عشق ننثره في المكتبات. الذين نحبهم, نهديهم مخطوطا لا كتابا, حريقا لا رمادا. نهديهم ما لا يساويهم عندنا بأحد بلزاك في أواخر عمره , وهو عائد من روسيا, بعد زواجه من السيدة هانكسا, المرأة الأرستقراطية التي تراسل معها ثماني عشرة سنة ومات بعد زواجه منها بستة أشهر, كان يقول لها والخيول تجر كهولته في عربة تمضي به من ثلوج روسيا الى باريس: " في كل مدينة نتوقف فيها, سأشتري لك مصاغا أو ثوبا. وعندما سيتعذر علي ذلك, سأقص عليك أحدوثة لن أنشرها ". ولأنه أنفق ماله للوصول اليها, ولأن طريق الرجعة كان طويلا, قد يكون قص عليها قصصا كثيرة. حتما, أجمل روايات بلزاك هي تلك التي لم يقرأها أحد, وابتكرها من أجل امرأة ما عادت موجودة هنا لتحكيها. ربما لهذا, أكتب هذا الكتاب من أجل الشخص الوحيد الذي لم يعد بامكانه اليوم أن يقرأه, ذلك الذي ما بقي منه الا ساعة أنا معصمها, وقصة أنا قلمها. ساعته التي لم أكن قد تنبهت لها يوما كانت له, والتي مذ أصبحت لي, كأني لم أعد أرى سواها. فمنه تعلمت أن أشلاء الأشياء أكثر ايلاما من جثث أصحابها. هو الذي أجاد الحب , وكان عليه أن يتعلم كيف يجيد موته. قال " لا أحب مضاجعة الموت في سرير, فقد قصدت السرير دوما لمنازلة الحب, تمجيدا مني للحياة". لكنه مات على السرير اياه. وترك لي كغيره شبهة حب, وأشياء لا أدري ماذا أفعل بها. ساعته أمامي على الطاولة التي أكتب عليها. وأنا منذ أيام منهمك في مقايضة عمري بها. أهديه عمرا افتراضيا. وقتا اضافيا يكفي لكتاية كتاب. تائها في تقاطع أقدارنا, لا أملك الا بوصلة صوته, لأفهم بأية مصادفة أوصلنا الحب معا الى تلك المرأة. أستمع دون تعب الى حواراتنا المحفوظة الى الأبد في تلك الأشرطة, الى تهكمه الصامت بين الجمل, الى ذلك البياض الذي كان بيننا, حتى عندما كنا نلوذ بالكلام. صوته! يا اله الكائنات, كيف أخذته وتركت صوته؟ حتى لكأن شيئا منه لم يمت. ضحكته تلك! كيف ترد عنك أذى القدر عندما تتزامن فاجعتان ؟ وهل تستطيع أن تقول انك شفيت من عشق تماما من دون أن تضحك, أو من دون أن تبكي! ليس البكاء شأنا نسائيا. لا بد للرجال أن يستعيدوا حقهم في البكاء, أو على الحزن إذن أن يستعيد حقه في التهكم. وعليك أن تحسم خيارك: أتبكي بحرقة الرجولة, أم ككاتب كبير تكتب نصا بقدر كبير من الاستخفاف والسخرية! فالموت كما الحب أكثر عبثية من أن تأخذه مأخذ الجد. لقد أصبح , لألفته وحميميته, غريب الأطوار. وحدث لفرط تواتره, أن أفقدك في فترات ما التسلسل الزمني لفجائعك, فأصبحت تستند الى روزنامته لتستدل على منعطفات عمرك, أو على حادث ما , معتمدا على التراتب الزمني لموت أصدقائك. وعليك الآن أن تردع نزعتك للحزن, كما لجمت مع العمر نزعتك الى الغضب,أن تكتسب عادة التهكم والضحك في زمن كنت تبكي فيه بسبب امرأة, أو بسبب قضية, أو خيانة صديق. مرة أخرى,الموت يحوم حولك إيغالا بالفتك بك, كلؤم لغم لا ينفجر فيك, وإنما دوما بجوارك. يخطئك, ليصيبك حيث لا ترى, حين لا تتوقع. يلعب معك لعبة نيرون, الذي كان يضحك, ويقول انه كان يمزح كلما انقض على أحد أصحابه ليطعنه بخنجره فأخطأه. اضحك يا رجل, فالموت يمازحك ما دام يخطئك كل مرة ليصيب غيرك |
|
#4
|
||||
|
||||
|
الفصل الثاني في مارس 1942 , سجن جان جنيه لسرقته نسخة نادرة لأحد دواوين بول فرلين, بعد أن تعذر عليه, وهو الفقير المشرد, شراءها. وعندما سئل أثناء التحقيق:"أتعرف ثمن هذه النسخة التي سرقتها؟" أجاب جنيه الذي لم يكن قد أصبح بعد أحد مشاهير الأدب الفرنسي المعاصر:"لا... بل أعرف قيمتها". تذكرت هذه الحادثة, عندما بلغني أنني حصلت على جائزة العام, لأحسن صورة صحفية في مسابقة"فيزا الصورة" في فرنسا. ربما لأنني عندما سرقت تلك الصورة من فك الموت, لم أكن أعرف كم سيكون سعرها في سوق المآسي المصورة. ولكنني حتما كنت أعرف قيمتها, وأعرف كم يمكن لصورة أن تكون مكلفة, وقد كلفتني قبل عشر سنوات, عطبا في ذراعي اليسرى. في صور الحروب التي أصبحت حرب صور, ثمة من يثرى بصورة, وثمة من يدفع ثمنا لها. وحدها صورة الحاكم الذي لا يمل من صورته, تمنحك راحة البال, إن كان لك شرف مطاردته يوميا في تنقلاته لالتقاطها. لكنك متورط في المأساة, وفي تاريخ كان ينادى فيه للمصور كما في اليمن السعيد في الخمسينات, ليلتقط لحظات إعدام الثوار وتخليد مشهد رؤوسهم المتطايرة بضربات السيوف في الساحات. أيامها, كان قطع الرؤوس أهم إنجاز, وعلى المصور الأول والأوحد في البلاد أن يبدأ به مهنته. ذات يوم, تنزل عليك صاعقة الصورة, تصبح مصورا في زمن الموت العبثي. كل مصور حرب, مشروع قتيل يبحث عن صورته وسط الدمار. ثمة مخاطرة في أن تكون مصورا للموت البشع. كأنه دمارك الداخلي. ولن يرمم خرابك عندذاك, حتى فرحة حصولك على جائزة. المشاهير من مصوري الحروب الذين سبقوك إلى هذا المجد الدامي, يؤكدون:" أنت لن تخرج سالما ولا معافى من هذه المهنة". لكنك تقع على اكتشاف آخر: لا يمكنك أن تكون محايدا , وأنت تتعامل مع الرؤوس المقطوعة, واقفا وسط برك الدم لتضبط عدستك. أنت متورط في تغذية عالم نهم للجثث, مولع بالضحايا, وكل أنواع الموت الغريب في بشاعته. دكتاتورية الفرجة تفرض عليك مزيدا من الجثث المشوهة. إنهم يريدون صورا بدم ساخن, مما يجعلك دائم الخوف على صورك أن تبرد, أن يتخثر دمها ويجمد قبل أن ترسلها , هناك حيث من حنفية المآسي, تتدفق صور الإفناء البشري على الوكالات. أثناء ذلك, بإمكان الموتى أن يذهبوا إلى المقابر, أو أن ينتظروا في البرادات. لقد توقف بهم الموت, وجمدت صورتهم إلى الأبد على عدستك. ولن تدري أخلدتهم بذلك, أم أ،ك تعيد قتلهم ثانية. لا يخفف من ذنبك إلا أنك خلف الكاميرا, لا تصور سوى احتمال موتك. لكن هذا لا يرد الشكوك عنك. الجميع يشتبه في أمرك: " لصالح من أنت تعمل؟". أأنت هنا , لتمجيد إنجازات القتلة ومنحهم زهوا إعلاميا, أم بنقلك بشاعة جرائمهم تمنح الآخرين صك البراءة, وحق البقاء في الحكم؟ إلى أي حزب من أحزاب القتلى تنتمي؟ ولصالح من من القتلة ترسل صورك.. إلى الأعداء ! وستقضي وقتك في الاعتذار عن ذنوب لم تقترفها, عن جائزة لم تسع إليها, عن بيت محترم تعيش فيه, ولا بيت لغيرك من الصحافيين, عن صديقك الذي قتل, والآخر الذي ذات 13 حزيران قتل امرأته وانتحر.. بعد أن عجز عن أن يكون من سماسرة الصورة. كنت دائم الاعتقاد أن الصورة, كما الحب, تعثر عليها حيث لا تتوقعها. إنها ككل الأشياء النادرة.. هدية المصادفة. المصادفة هي التي قادتني ذات صباح إلى تلك القرية, وأنا في طريقي إلى العاصمة, آتيا من قسنطينة بالسيارة, برغم تحذير البعض. كنت مع زميل عندما استوقفتنا قرية لم تستيقظ من كابوسها, ومازالت مذهولة أمام موتاها. لم يكن ثمة من خوف, بعد أن عاد الموت ليختبئ في الغابات المنيعة المجاورة, محاطا بغنائه وسباياه من العذراوات, ولن يخرج إلا في غارات ليلة على قرية أخرى, شاهرا أدوات قتله البدائية التي اختارها بنية معلنة للتنكيل بضحاياه, مذ صدرت فتوى تبشر "المجاهدين" بمزيد من الثواب, إن هم استعملوا السلاح الأبيض الصدئ, من فؤوس وسيوف وسواطير, لقطع الرؤوس, وبقر البطون, وتقطيع الرضع إربا. قلما كان القتلة يعودون, لأنهم قلما تركوا خلفهم شيئا يشي بالحياة. حتى المواشي كانت تجاوز جثث أصحابها, وتموت ميتة تتساوى فيها أخيرا بالإنسان. كانت القرى الجزائرية أمكنة تغريني بتصويرها. ربما لأن لها مخزونا عاطفيا في ذاكرتي مذ كنت أزورها في مواكب الفرح الطلابي في السبعينات, مع قوافل الحافلات الجامعية, للاحتفال بافتتاح قرية يتم تدشينها غالبا بحضور رسمي لرئيس الدولة, ضمن مشروع ألف قرية اشتراكية. كان لي دائما إحساس بأنني قد عرفتهم فردا فردا, لذا عز علي أن أصور موتهم البائس, مكومين أمامي جثثا في أكياس من النايلون؟ هم الذين أولموا لنا بالقليل الذي كانوا يملكون, ما أحزنني أن أكون شاهد تصوير على ولائم رؤؤسهم المقطوفة. في زمن الهوس المرئي بالمذابح, وبالميتات المبيتة الشنيعة, من يصدق النوايا الحسنة لمصور تتيح له الصورة حق ملاحقة جثث القتلى ببراءة مهنية؟ ليست أخلاق المروءة, بل أخلاق الصورة, هي التي تجعل المصور يفضل على نجدتك تخليد لحظة مأساتك. في محاولة إلقاء القبض على لحظة الموت الفوتوغرافي, بإمكان المصور القناص مواصلة إطلاق فلاشاته على الجثث بحثا عن "الصورة الصفقة". فهو يدري أن للموت مراتب أيضا, وللجثث درجات تفضيل لم تكن لأصحابها في حياتهم. ثمة جثث من الدرجة الأولى, لأغلفة المجلات. وأخرى من الدرجة الثانية, للصفحات الداخلية الملونة. وثمة أخرى لن تستوقف أحدا , ولن يشتريها أحد. إنها صور يطاردك نحس أصحابها. هاهوذا الموت ممد أمامك على مد البصر. أيها المصور..قم فصور! ثم رأيته.. ماذا كان يفعل هناك ذلك, الصغير الجالس وحيدا على رصيف الذهول؟ كان الجميع منشغلين عنه بدفن الموتى. خمس وأربعون جثة. تجاوز عددها ما يمكن لمقبرة قرية أن تسع من أموات فاستنجدوا بمقبرة القرية المجاورة. في مذبحة بن طلحة, كان يلزم ثلاث مقابر موزعة على ثلاث قرى, لدفن أكثر من ثلاثمائة جثة. فهل الموت هذه المرة كان أكثر لطفا, وترك لفرط تخمينه بعض الأرواح تنجو من بين فكيه؟ كان الصغير جالسا كما لو أنه يواصل غيبوبة ذهوله. أخبرني أحدهم أنهم عثروا عليه تحت السرير الحديدي الضيق الذي كان ينام عليه والده. حيث تسلل من مطرحه الأرضي الذي كان يتقاسمه مع أمه وأخويه, وانزلق ليختبئ تحت السرير. أو ربما كانت أمه هي التي دفعت به هناك لإنقاذه من الذبح. وهي حيلة لا تنطلي دائما على القتلة, حيث انه في قرية مجاورة, قامت أم بإخفاء بناتها تحت السرير, غير أنهم عثروا على مخبئهن, نظرا لبؤس الغرفة التي كان السرير يشغل نصف مساحتها, فشدوهن من أرجلهن, وسحبوهم نحو ساحة الحوش حيث قتلوهن ونكلوا بجثثهن. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
ماذا تراه رأى ذلك الصغير, ليكون أكثر حزنا من أن يبكي؟
لقد أطبق الصمت على فمه, ولا لغة له إلا في نظرات عينيه الفارغتين اللتين تبدوان كأنهما تنظران إلى شيء يراه وحده. حتى انه لم ينتبه لجثة كلبه الذي سممه الإرهابيون ليضمنوا عدم نباحه, والملقاة على مقربة منه, في انتظار أن ينتهي الناس من دفن البشر ويتكلفوا بعد ذلك بمواراة الحيوانات. كان يجلس وهو يضم ركبتيه الصغيرتين إلى صدره. ربما خوفا, أو خجلا , لأنه تبول في ثيابه أثناء نومه أرضا تحت السرير, وما زالت الآثار واضحة على سرواله البائس. هو الآن مستند إلى جدار كتبت عليه بدم أهله شعارات لن يعرف كيف يفك طلاسمها, لأنه لم يتعلم القراءة بعد.ولأنه لم يغادر مخبأه, فهو لن يعرف بدم من بالتحديد وقع القتلة جرائمهم, بكلمات كتبت بخط عربي رديء, وبحروف مازال يسيل من بعضها الدم الساخن. أبدم أمه, أم أبيه , أم بدم أحد إخوته؟ هو لن يعرف شيئا. ولا حتى بأية معجزة نجا من بين فكي الموت, ليقع بين فكي الحياة. وأنت لا تعرف بأية قوة, ولا لأي سبب, تركت الموت في مكان مجاور, ورحت تصور سكون الأشياء بعد الموت, وصخب الدمار في صمته, ودموع الناجين في خرسهم النهائي. لك تكن تصور ما تراه أنت, بل ما تتصور أن ذلك الطفل رآه حد الخرس. عندما كنت ألتقط صورة لذلك الطفل, حضرني قول مصور أمريكي أمام موقف مماثل:"كيف تريدوننا أن نضبط العدسة وعيوننا مليئة بالدموع؟" ولم أكن بعد لأصدق, أنك كي تلتقط صورتك الأنجح, لا تحتاج إلى آلة تصوير فائقة الدقة, بقدر حاجتك إلى مشهد دامع يمنعك من ضبط العدسة. لا تحتاج إلى تقنيات متقدمة في انتقاء الألوان, بل إلى فيلم بالأبيض والأسود, مادمت هنا بصدد توثيق الأحاسيس لا الأشياء. أول فكرة راودتني, عندما علمت بنيلي تلك الجائزة العالمية عن أفضل صورة صحفية للعام, هي العودة إلى تلك القرية, للبحث عن ذلك الطفل. كانت فكرة لقائي به تلح علي, وتتزايد يوما بعد آخر, لتأخذ أحيانا بعدا إنسانيا, وأحيانا أخر شكل مشاريع فوتوغرافية أصور فيها عودة تلك القرية إلى الحياة. حتى قبل أن أحصل على مال تلك الجائزة, كنت قد قررت أن أخصص نصفه لمساعدة ذلك الصغير على الخروج من محنة يتمه. ونويت بيني وبين نفسي, أن أتكفل به مادمت حيا, بالقدر الذي أستطيعه. لا أدري ماالذي كان يجعلني متعاطفا مع ذلك الطفل: أيتمنا المشترك؟ أم كونه أصبح ابنا لآلة التصوير بالتبني؟ وماالذي جعلني أستعجل التخلص من شبهة مال كانت تفوح منه رائحة مريبة,لجريمة كان جرمي الوحيد فيها توثيق فظاعات الآخرين. كأنني كنت أريد تبييض ذلك المال وغسله, مما علق به من دم , باقتسامه مع الضحية نفسها. طبعا كانت تحضرني قصة زميلي حسين الذي من أربع سنوات حصل على الجائزة العالمية للصورة, عن صورته الشهيرة لامرأة تنتحب, سقط شالها لحظة ألم, فتبدت في وشاح حزنها جميلة ومكابرة وعزلاء أمام الموت, حد استدراجك للبكاء. لكأنها تمثال" العذراء النائحة" لمايكل أنجلو. وكان حسين, عند وصوله إلى قرية بن طلحة, وجد نفسه أمام أكثر من ثلاثمائة جثة ممدة في أكفانها. فتوجه إلى مستشفى بن موسى حيث أخذ صورة لتلك المرأة التي فاجأها تنتحب, والتي قيل له إنها فقدت أولادها السبعة في تلك المذبحة. بعد ذلك, عندما انتشرت الصورة وجابت العالم, اكتشف حسين أن المرأة ماكانت أم الأولاد بل خالتهم. كان قد أخذ صورة للموت في كامل خدعته. فكل عبثية الحرب كانت تختصر في صورة لامرأة وجدت مصادفة حيث عدسة المصور, وأطفال وجدوا مصادفة حيث براثن الموت. الموت, كما الحب, فيه كثير من التفاصيل العبثية. كلاهما خدعة المصادفات المتقنة. أما الأكثر غرابة فكون تلك المرأة , التي لم تقم دعوى ضد القتلة, ولا طالبت الدولة بملاحقة الجزارين الذين نحروا الأجساد الصغيرة لأقاربها السبعة, جاء من يقنعها بأن ترفع دعوى على المصور الذي صنع "مجده" وثراءه بفجيعتها, عندما اكتشفت أن للصورة حقوقا في الغرب لا يملكها صاحبها في العالم العربي. فتطوعت جمعيات لرفع الدعاوى على المجلات العالمية الكبرى التي نشرت الصورة, بذريعة الدفاع عن حياء الجزائري وهو ينتحب بعد مرور الموت! لا أصعب على البعض من أن يرى جزائريا آخر ينجح. فالنجاح أكبر جريمة يمكن أن ترتكبها في حقه. ولذا قد يغفر للقتلة جرائمهم, لكنه لن يغفر لك نجاحاتك. وكلما , بحكم المهنة أو بحكم الجوار, ازدادت قرابته منك, ازدادت أسباب حقده عليك, لأنه لا يفهم كيف وأنت مثله في كل شيء, تنجح حيث أخفق هو. جارك الذي لعبت وتربيت معه منذ الطفولة, لو غرقت لجازف بحياته لإنقاذك من الغرق. لكنك لو نجحت في البكالوريا, ورسب فيها, وستذهب إلى الجامعة, ويبقى هو مستندا إلى حائط الإخفاق. وذات يوم , ستخرج من مسدسه الرصاصة سترديك قتيلا مكفنا بنجاحاتك. عندما ظهر خبر نيلي الجائزة, أسفل الصفحة الأولى من الجريدة الأكثر انتشارا, تحت عنوان" جثة كلب جزائري تحصل على جائزة الصورة في فرنسا", وتلاه في الغد مقال آخر في جريدة بالفرنسية عنوانه" فرنسا تفضل تكريم كلاب الجزائر", أدركت أن ثمة مكيدة تتدبر, وأن الأمر يتجاوز مصادفة الاتفاق في وجهة نظر. كانت لعنة النجاح قد حلت بي, وانتهى الأمر. لكن, كان لا بد أن يمر بعض الوقت, لأكتشف أن خلف ذلك الكم من الحقد والتجني جهد "صديق". كان جاري في قسنطينة وتوسطت له لينتقل إلى العمل في العاصمة, في الجريدة نفسها التي أعمل فيها, فوفر علي بكيده كل طعنات الأعداء, وجعلني أرى في جثة ذلك الكلب من الوفاء ما يغني عن إخلاص الأصدقاء, بعدما قدمت له من الخدمات ما يكفي لأجعل منه عدوا. غير أن الموضوع عاد بعد ذلك ليشغلني في طرحه الآخر: تراهم منحوا الجائزة لصورة ذلك الطفل؟ أم لجثة ذلك الكلب؟ وماذا؟ وقد صدرنا إلى العالم مذابحنا على مدى سنوات, وتم إتلاف الحياة الشعورية لأناس أكثر من جثثنا, بعد أن أصبحت في ندرتها أكثر وقعا على أنفسهم من جثة الإنسان؟ أليست كارثة , لو أن ضمير الإنسان المعاصر أصبح حقا يستيقظ عندما يرى جثة كلب يذكره بكلبه, ولا يبدو مهتما بجثة إنسان آخر لا يرى شبها به, ولا قرابة معه, لأنه من عالم يراه مختلفا.. ومتخلفا عن عالمه. عالم جثث تتقاتل. شغلتني تلك الأسئلة, حد قراري العودة إلى تلك القرية, بحثا عن جواب في تفاصيل ذلك الموت المركب. ....* ذات صباح , قصدت رفقة زميل تلك القرية. احتطنا طبعا لمفاجآت الطريق, بعدم أخذنا بطاقاتنا المهنية معنا فيما لو وقعنا في قبضة حاجز أمني مزور, ينصبه الإرهابيون لاصطياد من يضطر لسلوك تلك الطرقات بالسيارة, ممن يعملون في " دولة الطاغوت" الكافرة, أي باختصار, أي أحد يملك بطاقة عليها ختم رسمي, ولو كان يعمل زبالا في البلدية, أو أي مخلوق لا تروق له هيئته, فيذبحونه إن لم تكن لهم حاجة به, أو يصطحبونه إلى مخابئهم إن كان ممن يحتاجون إلى خدماته. كانت ظاهرة الحواجز المزورة عمت وانتشرت, وأصبحت مشابهة تماما لحواجز رجال الأمن الحقيقيين , الذين سطا الإرهابيون على بزاتهم العسكرية وأسلحتهم, مما أوقع الناس في بلبلة وحيرة. فان هم اطمأنوا إلى حاجز, وأظهروا هوياتهم الحقيقية, قد يفاجأون به مزورا ويقتلون , كذلك العجوز الذي استبشر خيرا بحاجز أوقفه, وقال للعسكريين بمودة: - واش.. الكلاب ما همش هنا اليوم؟ فرد عليه أحدهم وهو يطلق عليه النار : - إحنا هم الكلاب! وان هم لم يحملوا أوراقهم الثبوتية خشية وقوعهم في قبضة حاجز مزور, وكان الحاجز لرجال أمن حقيقيين, اتهموا بأنهم إرهابيون, وعوملوا على هذا الأساس, بعد أن أصبح الإرهابيون أيضا يتنقلون بدون أوراق ثبوتية, مدعين أنهم موظفو دولة.. أو مجندون في الخدمة العسكرية. وهكذا كان الناس, حفاظا على سلامتهم, يتنقلون بلا هوية في جيوبهم, ولا بطاقة عمل ولا أوراق ثبوتية في حوزتهم, ولا مفكرة تشي بمواعيدهم وأسماء رفاقهم فتفضح مهنتهم. كان وصولي إلى تلك القرية بسلام, وبدون حادث يستحق الذكر, إنجازا تفاءلت به, لولا أنني لم أجد شيئا مما كنت أبحث عنه هناك. كانت قلوب الناس موصدة, كبيوت موتاهم. وكنت هناك تائها, في مهب الأسئلة: كيف أستدل على ذلك البيت, والبيوت جميعها متشابهة في بؤسها؟ كيف أتعرف على ذلك الجدار الذي كان يستند إليه الطفل , وقد غسلوا الجدران خوفا من ثرثرتها, في محاولة لغسل ذاكرة القرية من دم أبنائها؟ ومن أسأل عن ذلك الطفل, والأجوبة متناقضة في اقتضابها؟ البعض يقول إن جمعية لرعاية اليتامى تكفلت به. وآخر يقول إن أحد أقاربه حضر واصطحبه إلى قرية أخرى. وآخر يجزم أن الطفل اختفى ملتاعا, بعد أن رآهم يحملون جثة الكلب ويدفنونها في حقل بعيد. وآخر لم يسمع بوجود هذا الطفل. أو لعله لا يريد أن يسمع بوجودي, ولا صبر له على فضولي. الصدمة تجعلنا نفقد دائما شيئا متأخرا, شيئا يغرقنا في الصمت. لاأحد يثرثر هنا. حتى الجدران التي كانت تهذي بالقتلة, أصابها الخرس, مذ طليت بماء الكلس. أحزنني أن القرويين الذين كانوا يحتفون بالغرباء أصبحوا يخافونهم. والذين كانوا يتحدثون إليهم, ويتحلقون حولهم في السبعينات أصبحوا يقفون ببلاهة ليتفرجوا عليهم, وكأنهم قادمون إليهم من عالم آخر, حتى انك لا تدري بماذا تكلمهم. لكأن لغتهم ما عادت لغتك, بل هي لغة اخترعها لهم القهر والفقر والحذر. لغة المذهول من أمره مذ اكتشف قدره. التضاريس هي التي تختار قدرك, عندما في زمن الوحوش البشرية تضعك الجغرافية عند أقدام الجبال, وعلى مشارف الغابات والأدغال. أنت حتما على مرمى قدر من حتفك. في عزلتهم عن العالم,أصبحت لسكان تلك القرى النائية ملامح واحدة, يدفنون فيها في اليوم ذاته, اثر غارة ليلية تختفي بعدها من الوجود قرية بأكملها. انه موت, في عبثيته,مستنسخ من حياتهم الرتيبة , التي يتناولون فيها كل يوم وجبة واحدة من الطبق الواحد نفسه لكل أفراد العائلة , ويرتادون مقهى واحدا, يدخن فيه الكبار والصغار السجائر الرديئة نفسها المصنوعة محليا من العرعار الجبلي, وعندما يمرضون يذهبون إلى مستوصف ( الدشرة), حيث الطبيب الواحد , والدواء الواحد لكل الأمراض. وكل جمعة كانوا يلتقون في المسجد الوحيد ليصلوا ويتضرعوا للإله الواحد. حتى جاءهم القتلة فأفسدوا عليهم وحدانيتهم وقتلوهم باسم رب آخر. لكأنهم منذ أجيال يكررون الحياة ذاتها, ويموتون حربا بعد أخرى نيابة عن الآخرين, لوجودهم في المكان الخطأ نفسه. لكأنهم جاهدوا ضد فرنسا ودفعوا أكبر ضريبة في قسمة الاستشهاد, فقط لتكون لهم بلدية كتب عليها شعار" من الشعب والى الشعب" يرفرف عليها علم جزائري, وتتكفل بتوفير قبر لجثثهم المنكل بها بأيد جزائرية. تتركهم خلفك صامدين حتى الموت المقبل, في أكواخهم الحجرية البائسة مع مواشيهم الهزيلة. هؤلاء الذين لا تكاد تشبههم في شيء, لا صور لأسلافهم وأجدادهم تغطي جدران أكواخهم كما في بيتك, لأنهم منحدرون من سلالة التراب. تود لو ضممت رائحة عرقهم إلى صدرك, لو صافحت بحرارة أيديهم الخشنة المشققة. ولكنهم لا يمدون لك يدا. وحده الموت يمد لك لسانه حيثما وليت وجهك. أثناء مغادرتي, انتابني حزن لا حد له. فقد فاجأني منظر موجع لغابة كانت على مشارف تلك القرية, وتم بعد زيارتي الأخيرة حرقها حرقا تاما من قبل السلطات , لإجبار الإرهابيين على مغادرتها, بذريعة حماية المواطنين من القتلة. في كل حرب أثناء تصفية حساب بين جيلين من البشر, يموت جيل من الأشجار, في معارك يتجاوز منطقها فهم الغابات. "من يقتل من؟" مذهولا يسأل الشجر. ولا وقت لأحد كي يجيب جبلا أصبح أصلع, مرة لأن فرنسا أحرقت أشجاره حرقا تاما كي لا تترك للمجاهدين من تقية, ومرة لأن الدولة الجزائرية قصفته قصفا جويا شاملا حتى لا تترك للإرهابيين من ملاذ. باستطاعتنا أن نبكي: حتى الأشجار لم يعد بإمكانها أن تموت واقفة. ماذا يستطيع الشجر أن يفعل ضد وطن يضمر حريقا لكل من ينتسب إليه ؟ وبإمكان البحر أن يضحك: لم يعد العدو يأتينا في البوارج. إنه يولد بيننا في أدغال الكراهية. لا أدري لماذا أصابني منظر الأشجار المحروقة على مد البصر, بتلك الكآبة التي تصيبك لحظة تأبين أحلامك. لكأن شيئا مني مات باغتيال تلك الأشجار. أعادتني جثثها المتفحمة إلى زمن جميل قضى فيه آلاف الشباب من جيلي خدمتهم العسكرية في بناء " السد الأخضر". سنتان من أعمار الكثيرين ذهبتا في زرع الأشجار لحماية الجزائر من التصحر. كان الشعار الذي يطاردك في كل مكان آنذاك: "الجزائري يتقدم والصحراء تتراجع". أكان كل ذلك نكتة؟! مشتعلين كنا بزمن النفط الأول. وكانت لنا أحلام رمال ذهبية, تسربت من أصابع إلى جيوب الذين كانوا يبتلعون البلاد ويتقدمون أسرع من لهاث الصحراء. يا لسراب الشعارات! إنها خدعة التائه بين كثبان وطن من الرمال المتحركة, لا تعول على وتد يدق فيه, ولا على واحة تلوح منه! |
|
#6
|
||||
|
||||
|
هوذا النصف الخالي.. كيف وصلنا إليه؟ بل كيف اخترقنا الرمل وتسرب إلى كل شيء؟ لم نعد على مشارف الصحراء, بل أصبحت الصحراء فينا. إنه التصحر العاطفي.
حدث ذلك ذات ديسمبر 1978 عندما ترك لنا بومدين على شاشة التلفزيون ابتسامته الغامضة تلك , ورحل. كانت ملامحه أقل صرامة من العادة, ونظرته الثاقبة أقل حدة, ويده التي تعود أن يمررها على شاربيه وهو يخطب, كانت منهكة لفرط ما حاولت رفع الجزائر من مطبّات التاريخ. لم يقل شيئا. فلم يكن عنده يومها ما يقوله, هو الذي قالوا له في موسكو - التي قصدها للعلاج من مرض نادر وسريع الفتك- إن موته حتمي وعاجل. من الواضح أنه عاد كحصان سباق مجروح ليموت بين أهله, وليختبر حبنا له, بعد أن عانى في بداياته من الجفاء العاطفي لشعب كان يفضل عليه طلّة بن بلّة.. وعفوية طيبته. أصوله الريفية التي أورثته الحياء, وحياته النضالية التي صقلت كبرياءه جعلته يصر على هيبة الموت وحشمته, فمات كبيرا ميتة تشبه غموض شخصيته السرية المعقدة. ذات 29 ديسمبر, وبينما العالم يحتفل بأعياد الميلاد, كنا نودع جثمان الرجل الذي ولدت على يده مؤسسات الجزائر وأحلامها الكبرى, الرجل الذي كان لنزاهته لا يمتلك حتى بيتا, ولا عرفنا له أهلا, أو قريبا. ولكنه ترك لنا أجهزة وصيارفة تربوا تحت برنسه, سيتكلفون بقمع أحلامنا وإفقارنا , ورهن مستقبلنا لعدة أجيال . رحل مودعا بجداول الدموع التي لم يدري أنها ستتحول بعده إلى أنهار دماء. بكاه الناس كفاجعة تخفي مؤامرة. لكأن موته إشاعة ومرضه مكيدة. فالجزائري تعلم من حكم بومدين نفسه ألا يصدق أن ثمة موتا طبيعيا, عندما يتعلق الأمر برجال السياسة. ولذا رحل مكفنا بالأسئلة, ككل رجالات الجزائر الذين لفقت لهم ميتات وانتحارات وتصفيات انتقامية عابرة للقارات.. وللتاريخ. في الواقع, ثمة أمران لا يصدقهما الجزائري: الموت بسبب طبيعي, والثراء من مال حلال. فآلية التفكير لدى الجزائري الذي كان شاهدا على عجائب الحكم, تجعله يعتقد أن كل من مات قتل, وكل من أثرى سرق, وبسبب هذا الريب الجماعي انهار السد الأخضر للثقة, وابتلعتنا كثبان الخيانات. يحدث أن أحن إلى جزائر السبعينات. كنا في العشرين, وكان العالم لا يتجاوز أفق حينا, لكننا كنا نعتقد أن العالم كله كان يحسدنا . فقد كنا نصدر الثورة والأحلام, لأناس مازالوا منبهرين بشعب أعزل ركعت أمامه فرنسا. العالم كان جهاز تلفزيون يبث صورا بالأسود والأبيض نتحلق حولها كل مساء, غير مصدقين معجزة ذلك الصندوق العجيب. ولأننا كنا أول من أدخل التلفزيون إلى الحي, كانت الجارات تتقربن إلينا بإرسال طبق من الحلوى عصرا مع أولادهن, كي نسمح لهم بمشاهدة التلفزيون معنا. كانت لنا أنماط حياة متداخلة بحكم فرحة الإستقلال التي لمت شملنا, وجعلتنا نتعلم المساكنة دون أن ننعم بالسكينة, في بناية وأصبحت" غنيمة استقلال" بالنسبة للبعض, وضريبة نزاهة وحماقة بالنسبة لأبي, الذي بحكم مسؤوليته عن توزيع الأملاك الشاغرة التي تركها الفرنسيون بعد الإستقلال , أصر على الإقامة في شقة للإيجار غير دار إنه سيقضي قيها ما بقي من عمره, ولن يغادرها إلا بعد ثلاثين سنة إلى قبره, بعد أن تدهورت صحته, بالسرعة التي تدهورت بها حالة البناية, وتعطل به دولاب القدر كما تعطل مصعدها نهائيا بعد السنوات الأولى للإستقلال, ليقضي شيخوخته في لهاث صعود طوابقها الخمسة. في ذلك الزمن الأول لٌلإستقلال, بينما كان الجيران مشغولين بالتفرج على التلفزيون.. وعلينا, كنت من الجانب الآخر للشقة, أترقب بصبر مراهق, أن تنفح نافذة تلك السيدة البولونية, التي كانت تسكن مع زوجها الذي حضر مع مئات المهندسين التقنيين من الدول الاشتراكية, للنهوض بـ " الثورة الصناعية" في الجزائر, جاهلين الثورات الصغيرة الأخرى التي سيحدثونها في حياة الفتيان.. والفتيات. كانت الجزائر, الخارجة لتوها من الحرب, صبية تقع في حب من جاؤوا من كل العالم لتهنئتها وإدارة شؤونها, وتعرف مغامراتها العاطفية الأولى العابرة للقارات والجنسيات واللهجات.. من خلال آلاف قصص الحب التي ولدت بينها وبين الفلسطينيين والعراقيين والمصريين واللبنانيين الذين جاؤوا ليعملوا أساتذة ومهندسين ومستشارين, والذين وقعوا تحت سطوة اسمها, كما ليقتسموا معها بعض شرف تاريخها, وتقتسم معهم ما فقدت من عروبتها. بالنسبة لي, جاء الحب بولونيا. بحكم الجغرافية التي وضعت تلك المرأة الشقراء في مرمى بصري, في بناية تطل على شقتنا من الجانب الآخر, ولكن بمسافة تحترم وجاهة ذلك الشارع الذي هندسته فرنسا بما يليق بالمباني الرسمية المجاورة له من فخامة. شاهدتها ذات صباح ترتدي روب الحمام الأبيض, وتقوم بتجفيف شعرها أمام المرآة. لم يكن يبدو منها شيئا عاريا. ربما لأنها كانت تدري أن العيون تتجسس عليها. لكنها كانت شهية بشعرها المبلل وحركاتها المغرية عن غير قصد. يومها اختزنت ذاكرة فتوتي صورتها, لتصبح مع العمر رمزا للغواية النسائية التي أصبح من شروطها عندي ألا تبدو المرأة عارية.. وإنما تظل مشروع عري موارب. كانت, ككل " الرفيقات" من الكتلة الاشتراكية, مشتعلة بجميع القضايا التي كان يقذفها بركان السبعينات من كل القارات. وكنت في عمر الاكتشافات الأولى, مشتعلا بها, وبتلك القضايا العالمية الأكبر من أن تحملها نملة بشرية مثلي. عندما تزوجت بعد ذلك بعدة سنوات, وجدتني أقيم في غرفة نوم. مقابلة لغرفة كانت غرفتها. كثيرا ما تأملت بيتا كان لسنتين مختبر تجاربي الأولى, ومرتعا لجنوني, قبل أن يضعه القدر مقابلا لما سيصبح حياتي الزوجية الفائقة التعقل.. والبرودة. دوما, ثمة امرأة أولى, تأتيها فتى مرتبكا خجولا, فتتعلم على يدها أن تكون رجلا, ثم أخرى بعد ذلك بسنوات, ستبهرها بما تعلمته, وتختبر فيها سطوة رجولتك. وحدها زوجتك, على جسدك أن يكون أبله وغبيا في حضرتها. فإن كنت اكتسبت خبراتك قبلها, ستتحاشى استعراضها أمامها عن حياء. وإن كنت كسبتها بعد الزواج, ستتفادى استعراضها عن ذكاء. ولذا يتسرب إكسير الشهوة في ما بينكما, وتسقط الأجساد في وهدة التآخي. كانت " أولغا" أول "حفرة نسائية" وقعت فيها. ولم أعد أذكر الآن من قال: "يسقط الرجل في أول حفرة نسائية تصادفه. فتاريخ الرجل هو تاريخ السقوط.. في الحفر". لكنني كثيرا ما تذكرت ضاحكا قول جدتي أثناء حديثها عن أبي الذي كثيرا ما بذر ثروته في النساء بسبب "فخاخ" تفنن في نصبها له :" من تمسك بأذناب البقر , رمين به في الحفر!". ليست الشهوة, بل اليتم, ما يلقي بفتى في أول حفرة نسائية يصادفها, بحثا عن رحم يحتويه, عساه ينجبه من جديد. قبل "أولغا" لم تكن تعنيني النساء, بقدر ما كانت تعنيني الحيوانات .. والأشياء. النساء جميعهن كن يختصرن في جدتي لأبي, المرأة التي احتضنت طفولتي الأولى مذ غادرت سرير أمي رضيع وانتقلت للنوم في فراشها لعدة سنوات. على فراشها الأرضي, بدأت مشواري كعابر سرير ستتلقفه الأسرة واحدا بعد الآخر حتى السرير الأخير. ثمة شيء في طفولتك حدث. وبدون أن تعي ذلك , كل سيء سيدور حوله ,إلى آخر لحظة من حياتك. لأنك لم تناد امرأة يوما " أمي" ليست علاقتك مع اللغة وحدها التي ستتضرر, بل كل علاقاتك بالأشياء. مثل "روسو" يمكن أن أختصر حياتي بجملة بدأ بها سيرته الذاتية في كتابه " اعترافات" : " مجيئي إلى الحياة كلف أمي حياتها. وكان ذلك بداية ما سأعرفه من مآس". منذ يتمي المبكر, وأنا أقيم علاقة أمومة مع ما يحيط بي. أختار لي كل فترة أما حتى اليوم الذي تصدمني فيه الأشياء, وتذكرني أنني لست طفلها. الأمومة, اكتشفتها, كما عثر أرخميدس على نظريته وهو داخل حمامه. فذلك الوعاء الأبيض الكبير الذي يحتويني في فضاء مائي كجنين, حدث أن ولّد في داخلي إحساسا غريبا, جعل من مغطس الحمام أمي. فقد كنت أقضي فيه كل وقتي رافضا مغادرته خشية أن يفرغ من مائه, كما أتوقع أن تكون قد فرغت دماء أمي وهي تنزف بي لحظة الولادة. يحدث للأمومة أن تؤلمني, حتى عندما لا تكون لها قرابة بي, كتلك القطة التي كنت في طفولتي أطعمها, وأحنو عليها, وأجلسها في حجري وأنا أطالع كتبي المدرسية, ثم أصبحت فجأة شرسة, ترفض أن أحملها أو أمرر يدي عليها. ذات يوم, وقد تركت آثار مخالبها على يدي, نهرتني جدتي, وأمرتني أن أتركها وشأنها, لأنها حبلى ولا تحب أن يقربها أحد. فبكيت لأنني أدركت أنه في يوم ما سيصبح لها صغارا حقيقيون, وستتخلى عني. بعد ذلك رأيتها ترضعهم, تلعقهم, تتفقدهم واحدا واحدا . وعلى كثرتهم لا تفرط في واحد منهم, وتظل تبحث عنه لتعود به محمولا من عنقه بين فكيها. اليتم, كالعقم, يجعلك تغار من حيوان, وتطالب الله بحق التساوي به مادمت أحد مخلوقاته. أسئلتي الوجودية بدأت مع القطة: كيف تستطيع القطة أن تحمل صغيرها بين أنيابها من دون أن تؤذيه؟ وهل حقا هي تخفي صغارها عن أبيهم الذي يحدث عندما يجوع أن يأكلهم؟ وهل الآباء جميعهم قساة وغير مبالين؟ وهل ثمة قطط أكثر أمومة من نساء يحملن أثداء تذر اللبن وتضن بالرحمة؟ بعد ذلك, عندما كبرت, وخبرت يتم الأوطان, كبرت" أسئلة القطة" وأصبحت أكثر وجعا: هل يمكن لوطن أن يلحق بأبنائه أذى لا يلحقه حيوان بنسله؟ هل الثورات أشرس من القطط في التهامها لأبنائها من غير جوع؟ وكيف لا تقبل قطة, مهما كثر صغارها, أن يبتعد أحدهم عنها , ولا ترتاح حتى ترضعهم وتجمعهم حولها, بينما يرمي وطن أولاد إلى المنافي والشتات غير معني بأمرهم؟ وهل في طمر أوساخهم تحت التراب, هي أكثر حياء من رجال يعرضون بدون خجل, عار بطونهم المنتفخة بخميرة المال المنهوب؟ لم أبحث لهذه الأسئلة عن جواب, فـ " الأجوبة عمياء, وحدها الأسئلة ترى". |
|
#7
|
||||
|
||||
|
الفصل الثالث باريس ذات أيلول! كنا في خريف كأنه شتاء. قررت بدءا أن أنشغل بتبديد الحياة, بخمول من توقف لأول مرة عن الجري, فحلت به متاعب عمر. الأربعون. وكل ذلك الهدر, تلك الانكسارات , الخسارات, الصداقات التي ما كانت صداقات, الانتصارات التي ماكانت انتصارات, وتلك الشهوات... التي استوت على نار الصبر الخافتة. كنت أود لو استطعت اختبار طيش الغرباء. في صباحاتي المتأخرة , أحلم بنساء لا أعرف لهن أسماء, يشجعنك بدون كلام على اقتحامهن, نساء عابرات لضجر عابر. ولكن كيف تعبر ممالك المتعة, وقد سلبك الرعب الهارب منه جواز مرور رجولتك, وعليك أن تعيش بإثم الشهوات غير المحققة. لكأنني, في كل سرير, كنت أعد حقائبي لأسفار كاذبة نحو صدرها, أتململ في الحزن, بحثا عن حزن أنثوي أرحم, أستقر فيه. برغم سعادتي بالسفر, كان الحزن حولي يفخخ كل ما يبدو لغيري فرحا, بدءا بتلك الجائزة التي تجعلك تكتشف بسخرية مرة أنك تحتاج إلى أسابيع من مهانة الإجراءات, كي تتمكن من السفر إلى باريس, لاستلام جائزة صورة لا يستغرق وصولها بالإنترنت إلى العالم كله, أكثر من لحظة. ذلك أن "فيزا الصورة" هي تأشيرة للصورة, لا لصاحبها. وعولمة الصور لا تعني منح البشر حق الأشياء في التنقل! لا وقت لك لتسأل نفسك " من الأهم إذن : أنت .. أم صورة التقطتها؟". مشغول أنت. مدينة برغبات صاخبة تنتظرك. سلالم معدنية تتلقفك لتقذف بك نحو قاطرات المترو, فتختلط بالعابرين والمسرعين والمشردين, ويحدث وسط الأمواج البشرية, أن ترتطم بموطنك. لا ذاك الذي يكنس شوارع الغربة. أو عاطلا عن الأمل, يتسكع مثيرا للحذر والريبة. إنما وطنا آخر كان مفخرتك, وأجهز القتلة على أحلامه. بعد ذلك ستعرف أن الجزائر سبقتك إلى باريس, وأن تلك الرصاصة التي صوبها الإرهابيون نحو رأسها, جعلت نزفها يتدفق هنا بعشرات الكتاب والسينمائيين والرسامين والمسرحيين والأطباء والباحثين, وأن الفوج الجديد من جزائريي الشتات, قام بتأسيس عدة جمعيات لمساندة ما بقي في الجزائر من مثقفين على قيد الموت في قبضة الإرهاب. بعد وصولي بأيام قصدت المركز الثقافي الجزائري تسقطا لأخبار الوطن. ورغبة في الإطلاع على الصحافة الجزائرية التي لا تصل كل عناوينها إلى فرنسا. كان المبنى على جماله موحشا كضريح شيد لتأبين فاخر للثقافة بذريعة الاحتفاء بها. أو لعله شيد بذريعة وهب الاسترزاق بالعملة الصعبة , للذين في الزمن الصعب كسدت بضاعتهم في دكاكين الوطن. ماكانت برودته تشجع على تصفح هموم البلاد. ولم ينقذني يومها من الصقيع, سوى ملصقات كانت تعلن عن نشاطات ثقافية متفرقة في باريس. اكتفيت بأن أسجل في مفكرتي تاريخ عرض إحدى المسرحيات, وكذلك عنوان الرواق الذي يقام فيه معرض جماعي لرسامين جزائريين. ماكنت لأظن وأنا أقصد بعد يومين ذلك الرواق يوم الافتتاح, أن كل الأقدار الغريبة ستتضافر لاحقا انطلاقا من ذلك المعرض, لتقلب قدري رأسا على عقب. كانت القاعة تستبقيك بدفئها, كوقوفك تحت البرد, أمام عربات القسطل المشوي في شوارع باريس. دفء له رائحة ولون وكلمات, صنعها الرسامون أنفسهم لإحراجك عاطفيا, بفضلهم بين اللوحات بصور المبدعين الذين اغتيلوا , وبوضعهم علما جزائريا صغيرا جوار الدفتر الذهبي, وإرفاقهم دليل اللوحات بكلمة تحثك ألا تساهم في اغتيالهم مرة ثانية بالنسيان, وإهمال من تركوا خلفهم من يتامى وثكالى. تشعر برغبة في البكاء. تكاد تندم على زيارتك المعرض. أسافرت حتى هنا لتجد كل هذه الصور في انتظارك؟ احتدم النقاش يومها بين بعض الزوار, حول من يقتل من في الجزائر. كأنهم كانوا ينتظرون أن يلتقوا كي يختلفوا. تعذر علي مجادلتهم. وتعذر على مزاجي غير المهيأ لمزيد من الحزن تجاهل ذلك الكم من الاستفزاز المتراشق به بين الجمل. لم أطل البقاء. قررت العودة لاحقا في يوم من أيام الأسبوع. أذكر أنني قضيت عدة أيام قبل أن أقصد ذلك الرواق ذات ظهيرة, لوجودي في محطة مترو غير بعيدة عنه. كان كل شيء فيه يبدو يومها هادئا ومسالما. لا شيء من ضجيج الافتتاح. عدا صخب اللوحات في خبث تآمر صمتها عليك. رحت أتجول في ذلك المعرض, عندما استوقفت نظري مجموعة لوحات معروضة تمثل جميعها جسورا مرسومة في ساعات مختلفة من النهار بجاذبية تكرار مربك في تشابهه. كل ثلاثة أو أربعة منها للجسر نفسه: جسر باب القنطرة, أقدم جسور قسنطينة, وجسر سيدي راشد بأقواسه الحجرية العالية ذات الأقطار المتفاوتة, وجسر الشلالات مختبئا كصغير بين الوديان. وحده جسر سيدي مسيد, أعلى جسور قسنطينة, كان مرسوما بطريقة مختلفة على لوحة فريدة تمثل جسرا معلقا من الطرفين بالحبال الحديدية على علو شاهق كأرجوحة في السماء. وقفت طويلا أمام لوحات لها عندي ألفة بصرية, كأنني عرفتها في زمن ما, أو شاركت الفنان في رسمها. كانت على بساطتها محملة بشحنة عاطفية, تنحرف بك إلى ذاتك, حتى لكأنها تخترقك, أو تشطرك. فكرت, وأنا أتأملها, أن ثمة جسورا , وأخرى تعبرنا, كتلك المدن التي نسكنها, والأخرى التي تسكننا, حسب قول خالد بن طوبال في " ذاكرة الجسد". لا أدري كيف أوصلني التفكير إلى ذلك الكائن الحبري الذي انتحلت اسمه صحافيا لعدة سنوات. وكنت أوقع مقالاتي محتميا به, من رصاص الإرهابيين المتربص بكل قلم, واثقا بأن هذا الرجل لم يوجد يوما في الحياة, كما زعمت مؤلفة تلك الرواية. الفكرة التي راودتني لفرط حبي لشخصيته, ولتشابهنا في أشياء كثيرة, حتى إنه لم يكن يختلف عني سوى في كونه يكبرني بجيل, وإنه أصبح رساما بعدما فقد ذراعه اليسرى في إحدى معارك التحرير, بينما , بدون أن أفقد ذراعي, أصبحت أعيش إعاقة تمنعني من تحريكها بسهولة مذ تلقيت رصاصتين أثناء تصوير تلك المظاهرات. فكرت بسخرية أنه قد يكون شخص آخر قرأ ذلك الكتاب, وراح هذه المرة يسرق لوحات الرجل, ويرسم تلك الجسور التي كان خالد بن طوبال مولعا بها, مستندا إلى وصفها في تلك الرواية. لكن اللوحات ماكانت تبدو تمرينا في الرسم, بقدر ما هي تمرين على الشفاء من وجع يلمس فيه الرسام بريشته ممكن الألم أكثر من مرة, كما ليدلك عليه. إنه حتما أحد أبناء الصخرة وعشاقها المسكونين بأوجاعها. خلقت تلك اللوحات لدي فضولا مباغتا في إلحاحه, فقصدت المشرفة على المعرض, أحاول مد حديث معها كي تزودني بمعلومات عن الرسام. غير أنها قالت, وهي تدلني على سيدة أربعينية جميلة القوام, ينسدل شعرها الأحمر بتموجات على كتفيها: - ها هي السيدة المكلفة بتلك اللوحات, بإمكانها إمدادك بما تحتاجه من معلومات. قدمت لي المرأة نفسها بمودة, وبتلك الحرارة التي يتحدث بها الناس إلى بعضهم البعض في فرنسا في مثل هذه المناسبات ذات الطابع التضامني الإنساني. قالت: - Bonjour.. Je suis Francoise.. que puis – je pour vous? لم أكن أعرف بعد " ماذا تستطيعه هذه المرأة من أجلي". فأجبتها: - إني مهتم بهذه اللوحات. أتمنى لو أعرف شيئا عن صاحبها. ردت السيدة بحماسة: - إنها لزيان, أحد كبار الرسامين الجزائريين. قلت معتذرا: - سمعت بهذا الاسم.. لكنني مع الأسف لم أشاهد أعماله قبل اليوم. ردت: - أتفهم هذا . إنه ضنين العرض, ومقل الرسم أيضا, ولذا تنفد لوحاته بسرعة. كما ترى, معظم لوحاته بيعت. قلت, وأنا أقف أمام مجموعة الجسور: - غريب هذا الأثر الذي يتركه في النفس وقع هذا السلم اللوني. دورة النور بين لوحة وأخرى تعطيك إحساسا أنك ترافق الجسر في دورة نهاره, مع أن الألوان لا تتغير, إنها ذاتها. قالت: - لأنه تعلم الاختزال اللوني من أيام الحاجة. في البدء لم يكن لديه مال, فاقتصد في الألوان. كان له بالكاد ما يكفي لثلاثة ألوان أو أربعة, فرسم بألوانه جسرا. واصلت المرأة: - كل الرسامين لهم بدايات متقشفة. بيكاسو في أول هجرته إلى فرنسا رسم لوحات غلب عليها اللون الأزرق, ورأى النقاد سببا واحدا لمرحلته الزرقاء تلك: إن فقر المهاجر الجديد منعه من شراء ألوان أخرى وحدد خياره . فان غوغ رسم أكثر من لوحة لحقول الشمس لأنه لم يكن في حوزته سوى اللون الأصفر. كنت سأبدي لهذه المرأة إعجابي بثقافتها, لولا أن ذهني كان مشغولا كليا بذلك الرسام الذي بدأت أتعاطف معه, وأحزن لبؤسه. وكعادتي رحت أفكر في طريقة تمكنني من مساعدته. قلت لها: - لا أفهم.. ألا يكون أحد فكر في مساعدة رسام موهوب كهذا, لا يملك ثمن شراء ألوان للرسم؟ ضحكت السيدة وقالت: - الأمر ليس هكذا.. كنت أحدثك عن بداياته, عن هذه اللوحة التي رسمها قبل أربعين سنة يوم كان يعالج في تونس أثناء حرب التحرير. أشارت بيدها إلى لوحة " الجسر المعلق". |
|
#8
|
||||
|
||||
|
دققت في اللوحة: في أسفلها كتب: تونس 1956 .
شيء ما بدأ يشوش ذهني. فكرة مجنونة عبرتني, ولكنني استبعدتها خشية أن أشكك في قواي العقلية. قلت: - ظننته شابا.. كم عمره إذن؟ - إنه ستيني. - وما الذي أوصله إلى هذه الجسور؟ - هوسه بقسنطينة طبعا! غالبية هذه اللوحات رسمها منذ 10 سنوات, حدث أن مر بفترة لم يكن يرسم فيها سوى الجسور. هذا بعض ما بقي من ذلك الجنون. معظمها بيعت في معارض سابقة. خشيت فجأة, إن أنا واصلت الأسئلة, أن أقع على اكتشاف مخيف. سألتها وكأنني أهرب من مفاجأة لا أدري عواقبها: - وماذا يعرض غير لوحات الجسور هذه؟ قالت مشيرة إلى لوحة تمثل شباكا بحرية محملة بأحذية بمقاييس وأشكال مختلفة تبدو عتيقة ومنتفخة بالماء المتقاطر منها: - هذه اللوحة . إنها من أحب لوحاته إلي, وأعجب ألا تكون بيعت حتى الآن. وأمام ما بدا مني من عدم إعجاب بلوحة لم أفهمها, قالت موضحة: - هذه رسمها زيان تخليدا لضحايا مظاهرات 17 أكتوبر 1961 , خرجوا في باريس في مظاهرة مسالمة مع عائلاتهم للمطالبة برفع حظر التجول المفروض على الجزائريين, فألقى البوليس بالعشرات منهم موثوقي الأطراف في تهر السين. مات الكثيرون غرقا, وظلت جثثهم وأحذية بعضهم تطفو على السين لعدة أيام, لكون معظمهم لا يعرف السباحة. قلت وأنا أقاطعها حتى لا أبدو أقل معرفة منها بتاريخي: - أدري.. ما استطاع Papon المسؤول آنذاك عن الأمن في باريس, أن يبعث بهم إلى المحرقة كما فعل مع اليهود قبل ذلك, فأنزل عشرين ألفا من رجاله ليرموا بهم إلى " السين" . كان البوليس يستوقف الواحد منهم سائلا" محمد.. أتعرف السباحة؟" وغالبا ما يجيب المسكين "لا" كما لو كان يدفع عنه شبهة. وعندها يكتفي البوليس بدفعه من الجسر نحو "السين" . كان السؤال لمجرد توفير جهد شد أطرافه بربطة عنقه! واصلت المرأة بنبرة فرحة هذه المرة: - إن جمعية لمناهضة العنصرية استوحت من هذه اللوحة فكرة تخليدها لهذه الجريمة. قامت في آخر ذكرى لمظاهرات 17 أكتوبر بإنزال شباك في نهر السين تحتوي على أحذية بعدد الضحايا. ثم أخرجت الشباك التي امتلأت أحذيتها المهترئة بالماء, وعرضتها على ضفاف السين للفرجة, تذكيرا بأولئك الغرقى. فقدت صوتي فجأة أمام تلك اللوحة التي ماعادت مساحة لفظ نزاعات الألوان , بل مساحة لفظ نزاعات التاريخ. شعرت برغبة في أن أضم إلى صدري هذه المرأة التي نصفها فرانسواز, ونصفها فرنسا. أن أقبل شيئا فيها, أن أصفع شيئا فيها, أن أؤلمها, أن أبكيها, ثم أعود إلى ذلك الفندق البائس لأبكي وحدي. أبدأت لحظتها أشتهيها؟ قطعت فرانسواز تفكيري, وفاجأتني معتذرة لارتباطها بموعد, وتركتني أمام تلك اللوحة مشتت الأفكار أتأملها تغادر القاعة. في المساء, لم يفارقني إحساس متزايد بالفضول تجاه ذلك الرسام, ولا فارقني منظر تلك اللوحة التي أفضت بي إلى أفكار غريبة, وأفسدت علاقة ود أقمتها مع نهر السين. حتما, هذا الرسام تعمد رسم ما يتركه الموتى. فالشباك عذابنا لا الجثة. تعمد أن يضعك أمام أحذية أكثر بؤسا من أصحابها, مهملة كأقدارهم, مثقلة بما علق بها من أوحال الحياة. تلك الأحذية التي تتبلل وتهترئ بفعل الماء, كما تتحلل جثة. إنها سيرة حياة الأشياء التي تروي بأسمائها سيرة حياة أصحابها. قضيت السهرة متأملا في أقدار أحذية الذين رحلوا, هؤلاء الذين انتعلوها بدون أن يدروا أنهم ينتعلون حذائهم يومها لمشوارهم الأخير. ما توقعوا أن تخونهم أحذيتهم لحظة غرق. طبعا, ما كانت قوارب نجاة, ولكنهم تمسكوا بها كقارب. أحذية من زوج وأخرى من واحدة, مشت مسافات لا أحد يعرف وجهتها, ثم لفظت أنفاسها الأخيرة عندما فارقت أقدام أصحابها. كانوا يومها ثلاثين ألف متظاهر ( وستين ألف فردة حذاء). سيق منهم اثنا عشر ألفا إلى المعتقلات والملاعب التي حجزت لإيوائهم. غير أن " السين" الذي عانى دائما من علة النسيان, ما عاد يعرف بالتحديد عدد من غرق يومها منهم. رحت أتصور ضفاف السين بعد ليلة غرق فيها كل هؤلاء البؤساء, وتركوا أحذيتهم يتسلى المارة باستنطاقها. فهذه عليها آثار جير وأخرى آثار وحل وثالثة... ماذا ترى كان يعمل صاحبها, أدهانا؟ أم بناء؟ أم زبالا؟ أم عاملا في طوابير الأيدي السمر العاملة على تركيب سيارات "بيجو"؟ فلا مهنة غير هذه كان يمارسها الجزائري آنذاك في فرنسا. أحذية كان لأصحابها آمال بسيطة ذهبي مع الفردة الأخرى. فردة ما عادت حذاء, إنها ذلك الأمل الخالي من الرجاء, كصدفة أفرغت ما في جوفها, مرمية على الشاطئ. ذلك أن المحار لا يصبح أصدافا فارغة من الحياة, إلا عندما يشطر إلى نصفين, ويتبعثر فرادى على الشاطئ. كان آخر ما توصلت إليه, بعد أرق ذهب بي في كل صوب, أ، أقصد في الغد الرواق لأشتري لوحة الأحذية, كسبا لصداقة فرانسواز, ولأساهم في ذلك المعرض الخيري بشراء لوحة وجدتني أعشقها. في الواقع, كان هذا مشروعي العلني. أما مشروعي الآخر فأن ألتقي بفرانسواز مرة أخرى, وأواصل استنطاقها أكثر عن ذلك الرسام. عاماً ونصف عام في سرير التشرد الأمني, عشت منقطعا عن العالم, أتنقل بحافة خاصة إلى ثكنة تم تحويلها لأسباب أمنية إلى بيت للصحافة يضم كل المطبوعات الجزائرية باللغتين, لا أغادرها إلا إلى إقامتي الجديدة. كان مكاناً يصعب تسميته, فما كان بيتاً, ولا نزلاً , ولا زنزانة. كان مسكناً من نوع مستحدث اسمه " محمية" في شاطئ كان منتجعا, وأصبح يتقاسمه " المحميون" ورجال الأمن. تحتمي فيه من سقف الخوف بسقف الإهانة. فما كانت القضية أن يكون لك سرير وباب يحميك من القتلة, بل أن تكون لك كرامة. في صيف مازافران, أيام الخوف والغبن والذعر اليومي, كنت أدري أنها تقيم بمحاذاتي في بيتها الصيفي, على الشاطئ الملاصق لي, على النصف الآخر من العالم المناقض لبؤسي, في شاطئ (نادي الصنوبر), حيث توجد محمية بنجوم أكثر, محجوزة فيلاتها لكبار القوم. وكان في هذا عذاب لم أحسب له حساباً . أنا الذي اختار ذلك المنفى لأحتمي من حبها, أكثر من احتمائي من القتلة, وإذ الأمن العاطفي هو أول ما فقدت. أمن هناك تغذت كراهيتي لها ونما تمردي عليها؟ أن تكون بمحاذاتي, ولكن دائما في الجهة الأخرى المناقضة لي, لا شيء يوصلني إليها, هي التي لا يفصلني عنها مطر, ولا شمس, ولا رمل, ولا بحر.. ولا ذعر. أحيانا كنت أخرج إلى الشرفة أنتظرها بوحشة فنار بحري في ليل ممطر. عسى قوارب الشوق الشتوي تجنح بها إلي. أحلم بشهقة المباغتة الجميلة. بارتعاد لوعتها عند اللقاء. باندهاش نظرتها . بضمتها الأولى. كعمر بن أبي ربيعة " أقلّب طرفي في السماء لعله\ يوافق طرفي طرفها حين تنظر". ثم أذهب إلى النوم, ممنيا نفسي بالمطر, عساه يعمدنا على ملة العشق في غفلة من الموت والقتلة. مراد الذي قاسمني غرفتي الأمنية بعض الوقت, قبل أن يتحول من محميّ من السلطة إلى طريدتها. كان يعجب من وقوفي طويلا في الشرفة ويناديني إلى الداخل لأشاطره كأسا وشيئاً من الطرب. ولكوني ما كنت من مدمني الشرب, ولا من هواة الصخب, كثيرا ما أزعجه اعتذاري, وأساء فهم أعذاري, وخرج إلى الشرفة ليسحبني نحو الداخل قائلاً بتذمر لا يخلو من خفة دم تميزه: - يا راجل واش بيك.. يلعن بوها حياة. واش راك تخمم؟ شوف أنا ما على باليش بالدنيا.. يروحوا كلهم يقوّدوا.. كان مراد يمثل نكبة الجزائري مع بحره. يرى بحراً لا يدري كيف يقيم معه علاقة سليمة. فبين البحر وبينه توجس وريبة وسوء فهم تاريخي. ولذا كنا نسكن مدينة شاطئية جميلة تولي ظهرها للبحر, ويبادلها البحر عدم الاكتراث. هناك أدركت قول بورخيس " البحر وحيد كأعمى" .. أو ربما أدركت أنني كنت البحر! ....* عندما هاتفته في الصباح عاتبني لأنه تعب في الحصول على رقمي في باريس, ثم بسخريته الجزائرية المحببة إلى قلبي راح يمازحني مدعياً أنني نسيته مذ حصلت على جائزة لجيفة كلب بدل أن أصور وسامته التي دوخت الأوربيات, حتى أصبحت سيارة الإسعاف تسير وراءه لإخلاء من يقعن مغمى عليهن.. لدى رؤيته. - " الأمبيلانس" يا خويا وراي.. أنا نمشي وهي تهز في البنات..كيفاش ندير قل لي يرحم باباك؟! مراد كان يفوت الفرصة على الموت بالاستخفاف به. وربما كان مديناً لوجوده على قيد الحياة بمرحه الدائم, ومديناً لجمال يشع منه, باستخفافه أيضاً بالجمال, متجاوزا بذلك عقدة خلقته. وفي هذا السياق كان يسميني " الدحدوح" ليذكرني أن وسامتي النسبية لن تغطي على بشاعته. وكانت له في هذا نظرية تستند إلى مقولة المغني الفرنسي سيرج غاسبور " إن البشاعة أقوى من الجمال لأنها أبقى". فبرغم بشاعته حصل غاسبور على فاتنات ما كن في متناول غيره وكأن القبح عندما يتجاوز ضفاف الدمامة, يصبح في فيضه النادر ضرباً من الجمال المثير للغواية. وكان في الأمر منطق يتجاوز فهمي. قد يشرحه من الطرف الآخر, قول بروست " لندع النساء الجميلات للرجال الذين لا خيال لهم". لذا كان مراد يراهن على خيال الإناث, محطماً خجل العوانس والنساء الرصينات بمباغتهن بممازحته الفاضحة. |
|
#9
|
||||
|
||||
|
في أحد لقاءاتي به لاحقاً, ضربت له موعدا في الرواق, بعد أن أبدى اهتمامه بزيارة معرض زيان. كنا نتجول بين اللوحات التي تتقاسم معظمها فكرة الجسور والأبواب العتيقة المواربة, عندما انضمت إلينا فرانسواز التي عرّفته بها قبل ذلك. راحت تسأله بتردد, كيف وجد المعرض. وبعد حديث جدي استعرض فيه سعة ثقافته الفنية أضاف فجأة:
- كجزائري أفهم وجع زيان, وأدري المأساة التي تحملها لوحاته, لكني كمتلق أجد في هذه الجسور الممدة وهذه الأبواب المواربة رمزاً أنثوياً. ولو كان لي أن أختار عنواناً لهذا المعرض لسميته " النساء". وراح أمام عجبنا يشرح فكرته: - الباب الموارب هو الغشاء الذي تقبع خلفه كل أنوثة مغلولة بقيد الانتظار. ما هو مشروع منه ليس سوى تلك الدعوة الأبدية للولوج, أما بعضه المغلق, فذلك هو التمنع الصارخ للإغواء.. لذا لم أعرف للنساء باباً عصياً على الانفتاح. إنها قضية وقت يتواصى بالصبر. نزل علينا أنا وفرانسواز صمت مفاجئ. شعرت بارتباك أنوثتها. كأنما بدأت أبوابها بالانفتاح أمام ذلك الرجل الذي لم تكن توليه اهتماماً في البدء. لا أدري من أين جاء مراد بذلك التحليل الفرويدي, فقد اعتاد أن يقحم الجنس في كل شيء. حتى إنه ذات مرة راح يقنعنا أثناء مرافعة سياسية دفاعاً عن الديمقراطية, أن الجزائريين ككل العرب ما استطاعوا أن ينجزوا من الانتصارات غير تلك الشعارات المذكرة, فدفعوا من أجل فحولة الاستقلال ملايين البشر, بينما استخفوا بالشعارات المؤنثة, استخفافهم بنسائهم. ولذا كان هوس مراد في المطالبة بتذكير كلمات " الديمقراطية" و " الحرية" عساها تجد طريقها إلى الإنجاز العربي. عندما حاولت معارضة فكرته, متحججاً بانتماء زيان لجيل لا يرى الأمور بهذه الطريقة, قال: - الإبداع وليد أحاسيس ودوافع لا شعورية وأنت لن تدري أبداً, مهما اجتهدت, ماذا كان يعني مبدع بلوحة رسمها أو بقصيدة نظمها. قلت: - إن كنت تعرف حياة المبدع, تدرك ما أراد إيصاله إليك. حياته هي المفتاح السري لأعماله. عندما اشتد بنا النقاش قال متهكماً: - بربك, كيف تحارب الذين يمنعون عنك حرية الرأي إن كنت ترفض عدم تطابقي معك في تفسير لوحة؟ " الحقيقة في الفن هي التي يكون نقيضها حقيقة كذلك". أكثر من قناعتي برأيه, كنت على قناعة بضرورة إبعاد هذا الرجل عن فرانسواز, حتى لا يفسد علي ما كنت أخطط له منذ شهر, خاصة أنه بعد ذلك عندما جلسنا في المقهى, راح بمزاح لا يخلو من الجدية يوضح لي ما يعتقده شبهاً بين نوعية الأبواب, وما يقابلها من أجناس النساء. فهو يرى الأوربيات مثلا, كالأبواب الزجاجية للمحلات العصرية التي تنفتح حال اقترابك منها, بينما تشهر العربيات في وجهك وقارهن كأبواب خشبية سميكة لمجرد إيهامك أنهن منيعات ومحصنات. وثمة من , حتى لا تستسهلهن,يتبعن بطء الأبواب اللولبية الزجاجية للفنادق التي تدور بك دورة كاملة كي تجتاز عتبة كان يمكن أن تجتازها بخطوة! وأخريات يحتمين بباب عصري مصفح, كثير الأقفال والألسنة, ولكنهن يتركن لك المفتاح تحت دواسة الباب.. كما عن غير قصد. كان الأمر بالنسبة إليه قضية صبر لا أكثر. لكنه كان يكره مهانة الانتظار خلف باب موصد. كان يحتكم إلى حاسة الفراسة ليعرف نوعية المرأة التي أمامه, وإلى خبرة اللصوص في اكتشاف أي نوع من الأبواب عليه أن يتحدى استعصاءه! وكنت على فرحي بوجوده معي, وحاجتي إلى ما أدخله إلى حياتي من حركة, قررت أن أجعل لقاءاتنا متباعدة, تفادياً لمناوراته الفحولية التي بدأت تحوم حول فرانسواز. في صباح اليوم التالي, قصدت الرواق بحثاً عن فرانسواز, كما لأتأكد من أنها ما زالت على ذلك القدر من اشتهائها إياي. لم أكن يوماً رجلاً للمغامرات العابرة. ولا كان يروق لي النوم في شراشف المصادفة. ولكن فرانسواز كانت تعنيني لسبب, وأصبحت تعنيني لسببين. قد أكون تعلقت بها لحطة شرود عاطفي من أجل رجل, هي المعبر الإجباري لأي طريق يوصل إليه. لكنني الآن أريدها بسبب رجل آخر قررت ألا أدعه يأخذها مني. فقط لأنه يمتلك جسارة ليست من طبعي. ....* كان في حوزتي ذرائع جميلة تعفيني من الإحساس بالذنب, إن أنا استسلمت لعروضها المواربة. في الواقع لم يكن لي مفر من تلك النوايا الخبيثة لأسئلة بريئة, تطرحها عليك امرأة تضمر لك متعة شاهقة.. أو هكذا تستنتج من كلامها. فرانسواز فتحت بجملة واحدة بوابة الشهوات الجهنمية, وتركتني مذهولاً لا أدري كيف أوقف سيل الحمم. أبمقاومتها, أم بالاستسلام لها؟ فأمام أي خيار من الخيارين كان احتمال ندمي قائماً. لتنجو من أسئلتك, عليك في الجنس أن تتغابى أحياناً, حتى لا تتنبه إلى كونك تذهب نحو المتعة, لأنك تحتاج إلى خيبة صغيرة تلهيك عن خيبات أكبر. ولذا أنت تحتاج إلى أكاذيب الجسد, إلى غبائه وفسقه وتناسيه, كي تقصد النزوات المسروقة من دون شعور بالذنب. أنت في حاجة إلى الإذعان للمتعة التي تهيئك للألم, وللألم اللذيذ المخدر الذي يهيئك للموت, مستندا إلى قول عنيف للمركيز دي ساد " لا طريق لمعرفة الموت أفضل من ربطه بمخيلة فاسقة". وأنت ستحتاج حتما إلى تلك المخيلة, لتوقظ صخب حواس ذكورية تعودت الاستكانة قهراً. تحتاج أن تضرم النار في رغبات مؤجلة دوماً. أنت المسكون بنزوات الذين يذهبون كل صباح نحو موتهم, يستعدون لمواجهة الموت بالصلاة حيناً, وبالآثام الأخيرة أحياناً أخرى. غير أن قبولي دعوة فرانسواز لقضاء " وقت ممتع" كان يحمل فرحة مشوبة بذعر لم أعرفه من قبل, خشية أن تخونني فحولتي عند اللقاء. حتى إنني, قبل ذلك بليلة, تذكرت مغنية أوبرا شاهدتها تقول في مقابلة تلفزيونية إنها في الليلة التي تسبق حفلاتها تعيش كابوساً مزعجاً ترى فيه نفسها تقف على المسرح وقد فقدت صوتها, مما يجعلها تستيقظ مذعورة كل مرة, وتجلس في سريرها لتجرب صوتها إلى أقصاه, كي تطمئن إلى قوته, ثم تخلد إلى النوم. تراني بلغت عمر الذعر الذكوري, وذلك الخوف المرضي من فقدان مباغت للفحولة, في تلك اللحظة الأكثر احتياجاً لها, أمام الشخص الذي تريد إدهاشه بالذات؟ أكل رجل هو مغني أوبرا مذعور, لا يدري لفرط صمت أعضائه كيف يختبر صوت رجولته! فرانسواز وجدت في تمنعي وعدم استعجالي الانفراد بها, شيئاً مغرياً ومثيراً للتحدي الأنثوي الصامت, ومثيراً أيضاً للاحترام. خاصة بعدما اعتذرت عن قبول عرضها الذي أظنه كان نابعاً من طيبتها في استضافتي بعض الوقت في بيتها, لتوفر علي مصاريف الإقامة المكلفة. قالت مثبتة حسن نواياها: - عندي غرفة إضافية يحدث أن يقيم فيها لبعض الوقت الأصدقاء العابرون لباريس, ومعظمهم من معارف زيان. آخر من شغلها زوجة مدير معهد الفنون الجميلة في الجزائر التي اغتيل زوجها وابنها داخل المعهد. كانت فكرة هذا المعرض لدعم عائلات المبدعين من ضحايا الإرهاب بمبادرة منها, ولهذا ارتأيت أن أستقبلها في بيتي لحاجتها إلى دعم نفسي كبير بعد هذه المحنة. لم تكن فرانسواز تدري أنها قالت العبارة التي كانت تكفي لإقناعي بأي شيء تعرضه علي بعد الآن. |
|
#10
|
||||
|
||||
|
سألتها مندهشاً:
- وهل زيان يقيم في بيتك؟ أجابت ضاحكة: - أجل , وإن شئت أنا من يقيم في بيته. فعندما عاد إلى الجزائر ترك لي البيت لفترة طويلة, ثم عرضت عليه بعد ذلك أن أتقاسم معه الإيجار. لقد كان الأمر يناسبني تماما. يدفع نصف إيجار البيت مقابل أن يشغله أحياناً عندما يزور باريس. إنني محظوظة حقاً. فهذا البيت جميل, ولم يعد بإمكانك العثور بسعر معقول على شقة كهذه تطل على نهر السين! لم أعد أصدق ما أسمع. سألتها: - وهل الشقة تطل على جسر ميرابو؟ ردت متعجبة: - هل زرتها؟ كنت سأبدو مجنوناً لو أخبرتها أنني سبق أن زرتها في رواية. فأجبت بهدوء كاذب: - لا .. قلت هذا لأنني أحب هذا الجسر, وتمنيت لو كان الأمر كذلك. - إنه فعلاً كذلك.. ولذا بإمكانك أن تزور الشقة كلما شعرت برغبة في رؤية ذلك الجسر. سألتها فجأة مجازفاً بكبريائي: - أما زال عرضك قائما باستضافتي لبعض الوقت في بيتك؟ - طبعاً.. ثم واصلت: - Oh.. mon Dieu.. comme tu me rappelles Ziane c'est fou.. tout ca pour un pont! طبعا.. كانت على خطأ. لم يكن " كل هذا بسبب جسر". وربما كانت في خطئها على صواب, مادامت قد صاحت " يا إلهي كم تذكرني بزيان". ذلك أن هذا الجسر ماكان بالنسبة لكلينا مجرد... جسر. أضافت: - بالمناسبة.. سيكون افتتاح معرض زيان بعد يومين. أتمنى أن أراك هناك. أجبتها وأنا أفكر في كل ما ينتظرني من مفاجآت بعد الآن: - حتماً.. سأحضر. |
 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 09:26 PM.





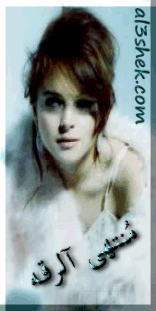



 العرض العادي
العرض العادي

